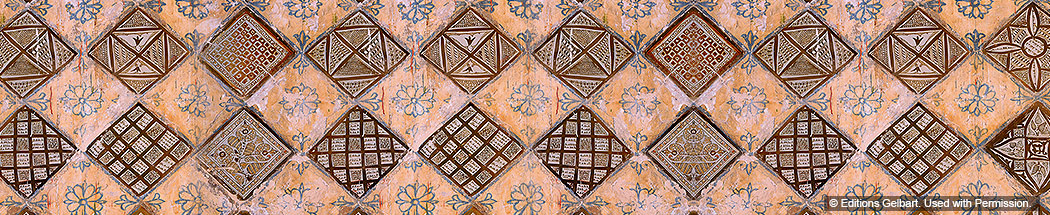قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
الفصل الخامس
مدخل إلى المسيحيّة
فالتر كاسبر (Walter Kasper)
1. تحديد المسيحيّة
من أراد أن يصف المسيحيّة يقع على الفور في حيرة. إذ لا يمكن تحديد المسيحيّة في صيغة مقتضبة. فالمسيحيّة تظهر في أوجه متعدّدة. فمنذ الألف الأوّل ظهر وجهان للمسيحيّة مختلفان أحدهما عن الآخر، واحدٌ في الشرق وآخر في الغرب، ما أدّى في القرن الحادي عشر، على أثر خلافات كبيرة ومجامع مسكونيّة حرّمت كثيرًا من البدع والهرطقات، إلى انفصال لا يزال قائمًا في يومنا هذا بين الشرق والغرب. وفي القرن السادس عشر حصلت خلافات في الكنيسة الغربيّة أدّت، على أثر حركة الإصلاح البروتستنتيّ، إلى تشعّب الكنيسة الواحدة إلى جماعات متعدّدة. وبعد عدّة قرون من الانفصالات ونشاة كنائس جديدة، عادت الكنائس، من خلال الحركة المسكونيّة، إلى العمل من أجل وحدة المسيحيّين. ولكن في الوقت نفسه نشهد في المسيحيّة داخل الكنائس الكبرى تمايزًا وتعدّدًا يتخطّى مجرّد التمييز بين نزعة تقليديّة محافظة ونزعة تقدّميّة. ففي هذا الجوّ من التعدّد، يُطرح السؤال ما هي الأمور الأساسيّة التي تجمع بين كلّ الكنائس، وتكوّن ما يمكن تسميته جوهر المسيحيّة، وما يجب الاستناد إليه في التفكير في مستقبل المسيحيّة في الألف الثالث؟
لقد شهدت المسيحيّة على مدى ألفي من تاريخها تطوّرات عميقة، ولا يزال التطوّر يسم اليوم أيضًا صورتها. إنّ تاريخ المسيحيّة الحاليّ محدّد من خلال تقليد العهد القديم والتحرّر من الشريعة اليهوديّة، ومن خلال القبول التاريخيّ للتراث المسيحيّ الأوّل في الإطار الثقافي اليوناني والرومانيّ والجرماني والغربي على وجه العموم، كما من خلال الرجوع إلى الثقافة القديمة في عصر النهضة، والإصلاح المرتكز على العودة إلى شهادات الكتاب المقدّس الأولى. إنّ حركات التجديد في عصرنا يجب النظر إليها على خلفيّة عالم متغيّر، ولا سيّما على خلفيّة سيطرة الثقافة الغربيّة من خلال انتشارها على مدى العالم كلّه من خلال العلم والتقنيّة. في هذه الحالة يتعيّن على المسيحيّة أن تُثبتَ بصورة جديدة طابعها الشموليّ الجامع. فهذه التطوّرات لا تختصّ فقط بالأشكال الخارجيّة بل أيضًا بمفهوم الإيمان. لذلك لا نجد أنفسنا أمام تاريخ لتكوين الكنيسة وما تحتوي عليه من شعائر وتقوى ولاهوت فحسب، بل أيضًا أمام تاريخ حقيقيّ لعقائد الكنائس المسيحيّة.
السؤال عن جوهر المسيحيّة، عمّا هو الأمر الحاسم والمميّز الذي يُلزم جميع المسيحيّين، لا يمكن، بناء على ما قلناه، الإجاة عنه بصيغ عامّة أو بجمل توجز الاعتراف بالإيمان أو التعليم المسيحيّ. فلكي تستطيع هذه التعابير أن تكون ملزمة بصورة ثابتة، يجب أن تُترجَم في لغة عصرنا وتساؤلاته. وهذا لم تتوصّل إليه أيّ من الكنائس ولا أيّ من لاهوتيّيها. ما يمكن قوله في الوقت الراهن هو أنّ المسيحيّة لا تصوَّر كمسيحيّة "مجرّدة"؛ فلا يمكن وصفها إلاّ انطلاقًا من تاريخها بما هو تاريخ حيّ.
بناء على هذه النظرة التاريخيّة للمسيحيّة ثمّة أمر مشترك بين جميع الذين يُدعَون مسيحيّين: إنّهم يستندون إلى تاريخ يسوع المسيح ومصيره، ويُثبتون أنّ شخصه و"قضيّته" يستمرّان اليوم من خلالهم. وإن توصّلوا في هذا الأمر إلى نتائج متنازع فيها، فإنّ نقطة انطلاقهم واحدة ومركزَهم واحد. وبما أنّ يسوع المسيح يكوّن ليس فقط البداية الوحيدة للمسيحيّة بل أيضًا أساسها وعلى نحو ما روحها، فهذا يحول دون تحويل المسيحيّة إلى مزيج من الأديان المتعدّدة. مع يسوع المسيح تحافظ المسيحيّة على "ذكرى خطرة" (ميتس J.B. Metz)، تساعد ليس فقط على تبرير المسيحيّة بل أيضًا على نقد كلّ ما تحقّقه في التاريخ. وبالتالي فما هو حاسمٌ ومميّز في المسيحيّة ليس فكرة أو مبدأ، بل إنّه اسم وشخص. ومن ثَمَّ يجب استنتاج المسيحيّة في خطوة أولى من التفكير انطلاقًا من تاريخ يسوع المسيح وتاريخ تجسيد حضوره في الكنيسة. وفي خطوة ثانية يمكننا أن نسأل ما الذي ينتج من هذا التاريخ بالنسبة إلى المفهوم المسيحيّ للإنسان وللعالَم، كما بالنسبة إلى علاقة المسيحيّة بالأديان الأخرى.
2. الاعتراف بيسوع المسيح
كلّ الكنائس المسيحيّة تعترف بيسوع المسيح؛ فتؤمن بأنّ الله قد أقامه من بين الأموات وبأنّه حاضرٌ حضورًا فعّالاً في الكنيسة من خلال كرازتها وأسرارها، وأنّه هو الذي في النهاية سيعتلن سيّد التاريخ. وتعترف بأنّ يسوع المسيح هو إله حقيقيّ وإنسان حقيقيّ. فالكلام على يسوع المسيح ليس بالتالي كلامًا على شخص يحمل اسمًا مزدوجًا، بل هو بالحريّ اعتراف إيمان بأنّ يسوع هو المسيح، أعني المخلّص النهائيّ المرسل من قِبَل الله؛ فمن خلاله يحقّق الله نفسُه الخلاص.
هذا الاعتراف الملزم جميع الكنائس يطرح اليوم أسئلة كثيرة. فمنذ التنوير في العصر الحديث وظهور البحث التاريخيّ النقديّ في الكتاب المقدّس، تعرّض هذا الاعتراف للتساؤل. فما أن بدأ النقد التاريخيّ بالتساؤل من كان يسوع في الحقيقة، وراح المؤرّخون يتحرّرون طبقة إثر طبقة من مجموعة التصوّرات الكنسيّة اللاحقة، ليكتشفوا من جديد الملامح الأصليّة لشخصه التاريخيّ، تبيّن التمييز بين يسوع التاريخيّ ويسوع الإيمان الكنسيّ. صحيح أنّ الأطروحة التي عُرِضت في بداية القرن العشرين والتي تدّعي بأنّ يسوع لم يعِش أصلاً بل هو مجرّد أسطورة قد تبيّن أنّها سخافة تاريخيّة. "المذود، وابن النجّار، والمندفع من بينَ الناس الوضعاء، وصليب العار في النهاية، كلّ هذا يمتّ إلى التاريخ وليس إلى العصر الذهبيّ الذي يهوى الأساطير" (بلوخ E. Bloch). ما لا يرقى إليه شكّ هو أنّ يسوع قد عاش في فلسطين في العقود الثلاثة الأولى من التاريخ الذي نعتمده اليوم، ربّما من سنة 6/7 قبل المسيح إلى سنة 30 بعد المسيح. أمّا الاعتراف بأنّ يسوع هو المسيح، والربّ، وابن الله، فلم ينشأ، بحسب ما نعرفه اليوم من التاريخ، إلاّ بعد موت يسوع في الجماعات المسيحيّة الأولى. وبالتالي تواجهنا مشكلة وهي كيف أنّ يسوع التاريخ صار مسيح الإيمان الكنسيّ. مع الإجابة عن هذا السؤال يتقّرر أيضًا السؤال بأيّ حقّ تستند الكنائس المسيحيّة إلى يسوع.
إنّ تاريخ "البحث عن حياة يسوع" الذي تناول هذه المسألة هو طويل ومتعرّج. فقد بدأ مع ريماروس S. Reimarus الذي نشر ليسينغ Lessing مقتطفاته. غير أنّ ثمّة مفترقات هامّة في تاريخ هذا البحث قد ظهرت عند شتراوس (D. F. Strauss)، وشلايرماخر (F. Schleiermacher)، وفريده (W. Wrede)، وشفايتسر (A. Schweitzer)، وبولتمن (R. Bultmann). فتمّ التشديد بنوع خاصّ على أنّ روح الربّ هو الذي ينعكس في يسوع. ثمّ كان يسوع الكارز بالأخلاق عند المتنوّرين، ثمّ يسوع الاختبار الباطنيّ عند التقويّين والليبراليّين، وبعد ذلك يسوع الذي يمثّل جوهر الإنسانيّة عند المثالانيّين، أو صديق الفقراء والثائر عند الاشتراكيّين. إنّ مشروع "البحث عن حياة يسوع" يُعَدّ اليوم مخفقًا بجملته. فالمصادر الأهمّ هي الأناجيل الأربعة القانونيّة؛ غير أنّها لم تُدوّن بصيغة يوميّات. ونظرًا إلى وضع المصادر هذا، يصير من نسج الخيال ادّعاء التمكّن من إعادة تكوين سيرة يسوع ووصف نفسيّيته. ومع ذلك يجب ألاّ يقودَنا هذا الأمر إلى الشكّ والخنوع. فالسؤال "الجديد" عن يسوع التاريخي في العقدين الأخيرين (كيزمان E. Käsemann، وفوكس E.Fuchs، وبورنكام G. Bornkamm)، وغيرهم قد أثبت بوضوح كبير أنّه من خلال ظلمة التاريخ تظهر إلى حدّ ما بجلاء الملامح المميّزة لكرازة يسوع وتصرّفه. نعلم علم اليقين أنّ يسوع قد انطلق من الكرازة المَعَاديّة التي قام بها يوحنّا المعمدان ومن حركة المعموديّة التي رافقتها، وأنّه نتيجة لتصرّفه قد حُكِم عليه بالموت على الصليب. وبين هذين القطبين يمكن تصوّر شخص يسوع و"قضيّته" ببعض الدقّة. أمّا تأكيد خلاف ذلك فيمكن تركه للهواة السذَّج من بين اللاهوتيّين.
في وسط بشارة يسوع تقوم الكرازة بقرب مجيء ملكوت الله. وبذلك يحتضن يسوع الترقّبَ الإنسانيّ العامّ لحاكم عادل والرجاء الخاصّ بالعهد القديم، الذي يرى أنّ الله نفسه في نهاية الزمن سيقيم الحقّ والعدل وينشئ السلام الشامل. لقد أظهر يسوع في تصرّفه وعمله أنّ ملكوت الله الخلاصيّ هذا قد بدأ. فتكلّم وتصرّف بسلطة مطلقة كواحد يقف مكان الله. هذه هي خلفيّة مؤاكلته للخطأة التي أثارت الاستياء، ومعجزاته التي أثارت العجب، والتي لا يمكن إنكار نواة تاريخيّة لها، وخصوصًا وعده بالخلاص للفقراء والمقهورين والمنبوذين والمضطهَدين. وقد كان ملكوت الله بالنسبة إليه ملكوت "الآب" (أبّا)، ملكوت محبّة الله، التي لا تقتصر على "نفس" الإنسان بل تشمل أيضًا جسده الذي، بحسب المفهوم العبرانيّ، لا يمكن على الإطلاق فصله عن النفس، وتقتضي ارتدادًا لا ينحصر في باطن الشخص، بل يشمل أيضًا العلاقات الاجتماعيّة في ما تتطلّبه محبّة القريب ومحبّة العدوّ. إنّ يسوع، بهذه الرسالة التي تتخطّى التصوّرات القائمة وبهذا المطلب، قد اصطدم بكلّ الفرق الدنيويّة والدينيّة في عصره ووقع في نزاع معها. وهكذا حُكم عليه بالموت بحجّة التجديف على الله والثورة. هو الذي كرز بقرب الله من المهمَلين مات مع كلّ علامات إهمال الله له. إنّ موَته على الصليب لا يمكن اعتباره، في منطق العهد القديم، إلاّ لعنة من الله.
وبما أنّ يسوع قد ربط "قضيّته" ربطًا تامًّا بشخصه، فإنّ موتَه يعني بالنسبة إلى تلاميذه إخفاق آمالهم. ولذلك لم تستطع المسيحيّة أن تضمَن مستقبلاً بعد موت يسوع إلاّ انطلاقًا من يقينها بأنّ الله قد تماهى مع المصلوب، أعني في لغة الرؤيويّة اليهوديّة أنّ الله قد أقامه من الموت، وأنّ يسوع هو الآن حاضر بطريقة جديدة، وبتعبير الكتاب المقدّس، حاضر "بالروح القدس". غير أنّ القيامة لم تُعتبَر في الكتاب المقدّس إحياء وعودة إلى الحياة القديمة، بل هي بدء لحياة جديدة ونهائيّة في ملكوت الله. ومن ثَمَّ فإنّ قيامة يسوع تعني تثبيت مطلبه المعاديّ ومباشرة العمل به. وقد أكّد بولس نفسه أنّ المسيحيّة بدون الإيمان بقيامة يسوع هي باطلة ولا أساس لها. بدون القيامة لا يكون يسوع سوى قتيل بريء ولا يصير أساسًا للرجاء بل بالحريّ مدعاة للشكّ والخنوع. والتلاميذ لم يستطيعوا أن يكتشفوا بوضوح وبدون لبس معنى حياة يسوع الأرضيّة إلاّ في ضوء الإيمان بالقيامة وقدرة هذا الإيمان. لذلك لا يتّخذ الاعتراف بيسوع و"بقضيّته" معناه الكامل إلاّ إذا ارتكز على الاعتراف بالمسيح القائم والحيّ.
وفي حين يمكن البحث من الوجهة التاريخيّة في تصرّف يسوع الأرضيّ وعمله، على غرار الظاهرات التاريخيّة الأخرى، فالاعتراف بيسوع القائم لا يخضع لأيّ بحث تاريخيّ أو من أيّ نوع آخر. إنّ العثور على قبر يسوع فارغًا يمكن تفسيره بطرق متعدّدة؛ ولم يكن بالنسبة إلى المسيحيّة برهانًا على القيامة، بل علامة متأخّرة للإيمان. ومن ثَمّ فما يمكن إدراكه تاريخيًّا ليس القيامة نفسها بل فقط إيمان التلاميذ الأوّلين بالقيامة. فيظهر هذا الإيمان منذ الطبقات الأولى للتقليد، ويمكن تصديقه من الناحية الإنسانيّة استنادًا إلى أنّ شهود هذا الإيمان الأوّلين قد قبلوا الاستشهاد من أجله. بالنسبة إلى وضع المصادر هذا، فإنّ النظريّات التي تتكلّم على خداع التلاميذ، أو تبديل القبر، أو الموت الظاهر، أو الرؤى الذاتيّة (الهلوسة)، أو تفكير التلاميذ اللاهوتيّ الخاصّ، تخلق مشكلات أكثر ممّا تحلّ. إنّ الاعتراف بقيامة المصلوب يصير "مفهومًا"، بالنسبة إلى الإيمان، انطلاقًا من مجمل ارتباط الرجاء المعاديّ ببرّ الله، هذا الرجاء المعاديّ بأنّ الله في النهاية سيكون "كلاًّ في الكلّ"، و"يمسح كلّ دمعة"، هو الأفق الحقيقيّ لفهم رسالة يسوع المسيح.
هذا الأفق المعاديّ الشامل قد فقده إلى حدّ بعيد التاريخ المسيحيّ اللاحق. إنّ نزع الطابع المعاديّ مرتبط بارتداء المسيحيّة الثوب الهلّينيّ. فما أن خرجت المسيحيّة عن المجال اليهوديّ، كان عليها بسبب مطلبها الشموليّ أن تستسلم للنقاش مع عالم الهلّينيّة ومع مطلب الشموليّة الذي تنطوي عليه فلسفة الكلمة (Logos). هذا الاصطباغ بالطابع الهلّينيّ لا يعني بذاته أيّ فساد للمسيحيّة، بل يدلّ فقط على أنّها قد تمّ استيعابها بصورة حيّة من قِبَل الثقافة القائمة يومئذٍ. ما قد يكون غير شرعيّ هو أن تتغلّب الهلّينيّة على المسيحيّة من الداخل. إنّ خطر الانزلاق في تلفيقيّة ذلك العصر العامة لم يكن خطرًا ضئيلاً، ومن الإنجازات البارزة للتطوّر العقيديّ في الكنيسة الأولى أنّه عرف بوضوح الحدود بين ما هو مشروع وغير مشروع في ارتداء الطابع الهلّيني، وتقيّد بها. بناء على مثل هذا "التعليق في التناقض"، توصّلت المجامع المسكونيّة الأولى، ولا سيّما نيقية (325) وخلقيدونية (451)، إلى العقيدة القائلة بأنّ يسوع المسيح هو إنسان حقيقيّ وإله حقيقيّ بدون امتزاج ولا انفصال.
لا جرم أنّ الثمن الذي كان على المسيحيّة أن تدفعه مقابل هذا الاستيعاب الحيّ كان عاليًا جدًّا. فبدل إله التاريخ الحيّ، كما شهد له العالم القديم والعهد الجديد، ظهر إلى حدّ بعيد، نتيجة لذلك، مفهوم لله يتّسم بطابع عدم التغيّر وعدم التألّم (apatheia). هذا المصطلح اليونانيّ لله يكاد لا يفسح في المجال للكلام على إمكانيّة أن يصيرَ الله إنسانًا أو أن يتألّم أو يموت. وبذلك وقعت رسالة المسيح في خطر فقدان معناها العميق، تلك الرسالة التي لا بدّ لها من أن تقول إنّ الله هو إله الناس، الذي في يسوع المسيح دخل في مرافق الحياة البشريّة ومخاطرها، وعانى عبث الموت، لينقذَنا من خلال عمله هذا. إنّ لاهوت المسيح هذا غير التاريخيّ والذي نُزع عنه إلى حدّ بعيد أفقه المعاديّ قد أفقد المسيحيّة كثيرًا من نظرتها المستقبليّة التي تأخذ بمجامع القلوب. فصارت في معظم الأحيان مجرّد قوّة محافظة.
إنّ الجمع الذي تمّ في تطوّر عقائد الكنيسة الأولى بين الحضارة القديمة والمسيحيّة قد صار أساس الثقافة الغربيّة بمجملها. ولذلك ليس من باب المصادفات أن توضَع أيضًا عقائد الكنيسة الأولى من جديد وبطريقة نقديّة موضعَ التساؤل، في عصرنا الذي تظهر فيه ضمن الأزمات بوادر حقبة جديدة. إنّ مطلب المسيحيّة الشموليّ يعني بدون شكّ أنّها غير مرتبطة بثقافة معيّنة بصورة حصريّة ونهائيّة. فلا يمكنها بالتالي الحفاظ على هويّتها واستمرارها إلاّ من خلال تبدّل تاريخيّ عميق. ولذلك يحاول اليوم كثير من اللاهوتيّين البروتستنتيّين والكاثوليكيّين ، ليس بمعزل عن حافز الفلسفة المثالانيّة الألمانيّة (فيخته Fichte، وشلّينغ Schelling، وهيغل Hegel)، أن يُظهروا من جديد وبأكثر جلاء الإله الحيّ، إله العهد القديم والعهد الجديد، الذي لا يجلس في علياء سماء لا يمكن الوصول إليها وهو غير مهتمّ لأهوال التاريخ، بل بالحريّ تبيّن في يسوع المسيح على أنّه إله الناس، والذي اعتلن جوهره العميق مرّة وبصورة نهائيّة على الصليب. فتساميه يجب ألاّ يُعتبَر بعدًا مكانيًّا، بل هو حريّة لا يمكن إدراكها ولا يمكن التصرّف بها، حريّة المحبّة المتجرّدة عن ذاتها. بناء على التسامي المفهوم على هذا النحو، يجب القول إنّ الله هو أيضًا حاضر حضورًا تامًّا في العالم؛ إنّه يلتقينا في يسوع الذي هو أخونا، وفي جميع الإخوة، ولا سيّما في ألم الجائعين والمرضى والمنبوذين والمضطهدين.
بموجز الكلام يمكن القول إنّ المسيحيّة تعتقد أنّ المعنى الأعمق لكلّ الكائنات، وسرّ الواقع الذي يشمل كلّ شيء وينفذ في كلّ شيء، الذي ندعوه الله، قد تبيّن في يسوع المسيح أنّه المحبّة التي تعطي ذاتها وتتجرّد عن ذاتها. إنّها تحقّق ذاتها بالضبط في عطاء ذاتها عطاء حرًّا؛ وفي ارتباطها بالآخر تحرّره. وقد وجد هذا الإيمان أسمى تعبير له في عقيدة الثالوث. هذه العقيدة، في مفهومها الصحيح، بعيدة كلّ البعد عن الاعتقاد بوجود ثلاثة آلهة، وليست متأثّرة بأيّ شرك، بل هي الاعتراف الشامل بأنّ الله قد تبيّن في يسوع المسيح أنّه ربّنا وأخونا، وبأنّه يلتقينا من خلال "الروح القدس" في كلّ إخوتنا. وبمعنى شامل يصل العهد الجديد إلى نهاية تطوّره إلى القول: "الله محبّة".
3. العلاقة بين الله والإنسان في التاريخ
في تاريخ العهد القديم والعهد الجديد، ولا سيّما في جمعهما الفريد في يسوع المسيح، اعتلن المفهوم المسيحيّ للعالم وللإنسان. وبالتالي فالمسيحيّة، في بشارتها بتاريخ واقعيّ، تتضمّن مطلبًا شموليًّا. لا تستطيع المسيحيّة أن تبرهن بصورة مجرّدة عن هذا المطلب الشامل، بل تقتصر على أن تشهدَ له واقعيًّا؛ لا يسعها سوى أن تتوجّه إلى الآخرين وتدعوهم إلى الإقدام على هذا التاريخ، ليختبروا في عمل الحقيقة أنّ صدقيّته تتجلّى في ظواهر الواقع. ومن ثَمّ لا تعتبر المسيحيّة ذاتَها فلسفة أو أيّة نظريّة إلى جانب غيرها من الفلسفات والنظريّات. ولا تعتبر ذاتَها أيضًا الفلسفة الحقيقيّة، إنّما هي بشارة (إنجيل)، تثبت أو تسقط مع التاريخ الذي تشهد له. إنّها وحدة العمل والكينونة، ووحدة الكينونة والزمن (التاريخ). ولذلك فالمقولات اللاهوتيّة هي تفسير لاختبار قام به الإيمان مع الاختبار البشريّ. سنعالج في ما يلي لاهوتيًّا ثلاثة من تلك الاختبارات ونوضح بالتالي ثلاث بُنى أساسيّة للإيمان المسيحيّ.
3-1. عقيدة الخلق
الاختبار الأساسيّ الأوّل للإيمان في لقائه مع الواقع هو اختبار شموليّته. وقد انعكس من ناحية العقيدة في الإيمان بالخلق. إنّ هذا الاعتقاد لم يظهر بصراحة في العهد القديم إلاّ عندما دخل إسرائيل في القرن السابع أو السادس قبل المسيح في اتّصال وصراع مع القوى العالميّة يومئذٍ (مصر وأشور وبابل)، ومع تصوّراتها لنشأة الكون. إنّ إيمان إسرائيل بأنّ الله هو الذي يدير الكون ورجاءه بالمجيء النهائيّ لملكوت الله كان لا بدّ أن يظهرا في هذا الوضع المحرج من خلال امتداده الشامل: الله هو سيّد على جميع الشعوب وعلى جميع الآلهة؛ إنّه سيّد على الواقع كلّه، وسيّد أيضًا على الحياة والموت؛ ولأنّ كلّ ما هو قائم يخضع له، ولأن لا وجود لشيء إلاّ به، ولأنّ لا وجود لأيّ مرجع مناقض يشبهه، من أجل ذلك كلّه يمكن الاستسلام له استسلامًا تامًّا في الإيمان والرجاء. إنّ عقيدة الخلق من العدم لم تكن سوى الصيغة السلبيّة للمقولة الإيجابيّة عن سيادة الله الشامل. وهي لا تعني إذن أنّ الله قد خلق الكون من العدم كما من مادة سابقة؛ فالتعبير عن سيادة الله المطلقة على كلّ الكائنات، تؤكّد بالحريّ عدم وجود أيّ شرط مسبق. ويجب بالتالي القول إنّ الله قد دعا العالم إلى الوجود بحريّة محبّته المطلقة. ولذلك فالكائنات متعلّقة تعلّقًا مطلقًا بالله، له تدين بوجودها، ومع ذلك فهي تنعم باستقلال ذاتي منحتها إيّاه محبّة الله.
ومن ثَمّ فالإيمان بالخلق قد نشأ كنتيجة وكمسوّغ للإيمان الكتابيّ بالتاريخ. ينتج من هذا أنّ القول بأنّ العالم هو خليقة الله ليس نظريّة في نشأة الكون، يمكن وضعها مقابل نظريّة التطوّر أو العمل على الانسجام بين النظريّتين. الخلق كمقولة لاهوتيّة والتطوّر كمقولة في علم الطبيعة لا يجيبان عن السؤال عينه. التطوّر يتعلّق بكائنات مفترضة من قَبل؛ وما يعالجه هو كيفيّة تغيّرها انطلاقًا من قواها الذاتيّة. الأقوال الكتابيّة في الخلق تستعمل طبعًا أقوالاً عن الكيفيّة تستقيها من تصوّر العالم الشائع آنذاك؛ غير أنّ قصدها ليس تفسير كيفيّة تكوينها، بل الإجابة عن السؤال الأكثر عمقًا والأكثر شمولاً لماذا وُجدت أصلاً؛ فالموضوع لا يتعلّق عندها بكيفيّة نشأة الكائنات وتطوّرها، بل بوجودها عينه، الذي هو وجود عارض وبالتالي غير واجب، ومن ثَمّ فالكون لا يملك في ذاته علّة وجوده.
مع القول بالخلق تعترف المسيحيّة بمفهوم للكون يتجاوز الاختيار بين الأحديّة والثنائيّة. الواقع، ولا سيّما المادّة وجسد الإنسان، ليس، في نظر الإيمان المسيحيّ بالخلق، مبدأ شرّيرًا مناقضًا لله، بل هو واقعٍ أراده الله واستحسنه، إنّه نعمة من نعم الله. وبذلك يقضي الإيمان بالخلق على فكرة اعتبار الواقع عملاً شيطانيًّا. ومن ناحية ثانية فهو لا يفسّر الواقع بطريقة أحاديّة، كأنّ الكون قد انبثق من الله. فالكون، باعتباره مخلوقًا من العدم، يختلف اختلافًا جذريًّا عن الله الخالق. وهذا يعني نزع صفة الألوهة وصفة الأسطورة عن العالَم ووضع الأساس لمفهوم "دنيوي" عن العالم. ومنذ رواية الخلق الأولى، تتحوّل النجوم، التي كان الشرق القديم قد اعتاد أن يعبدَها، إلى مجرّد مصابيح؛ ولا يترتّب على الإنسان أن يخدمها، إنّما هي في خدمة الإنسان، إذ تنير طريقه وتدلّه على الأوقات. وهكذا ينتقل الإنسان منذ العهد القديم إلى وسط الخليقة أو إلى قمّتها. والتمييز بين الله والعالم وما يتضمّنه من إلغاء للأسطورة يتيحان للكائنات أن تنعم باستقلالها كمخلوقات. وبهذا يتميّز الإيمان المسيحيّ من الخرافة. فبما أنّ الإيمان يميّز بين الله والعالم، يمكنه أيضًا أن يدع العالم يكون عالمًا قائمًا بذاته. إنّ استخلاص هذه النتائج هو الإنجاز الكبير الذي حقّقه لاهوت المدرسة في العصر الوسيط، ولا سيّما توما الأكويني. فعندما لا يُنظر إلى العالم إلاّ من خلال العالم، كما حدث مرارًا في العصر الحديث، حينئذٍ يصير من جديد جسمًا نهائيًّا وبالتالي صنمًا. مثل هذه " القوى والسلاطين" الشيطانيّة يراها الكتاب المقدّس بنوع خاصّ في السلطة السياسيّة التي تجعل ذاتها سلطة مطلقة (بابل، رومة) وكذلك في الغرور التقنيّ الحضاريّ للإنسان (برج بابل). إنّ اعتبار العالم صادرًا عن عطاء محبّة الله الحرّة والمحرّرة هو وحده يتيح للإنسان أن يُثبت كرامة العالم دون أن يُرغَم على أن يُسبغَ عليه إيديولوجيًّا صفة المطلق.
إنّ شموليّة الإيمان المسيحيّ التي يعبّر عنها الإيمان بالخلق منحت المسيحيّة عبر تاريخها القدرة الذاتيّة على تحمّل المسؤوليّات الدنيويّة وعلى إعطاء شكل للعالم. أمّا أن تكون المسيحيّة في هذا الأمر قد أساءت مرارًا فهمَ رسالتها وأنكرتها، بازدرائها وانتهاكها حريّة الإنسان والعالم، فهذا واقع تاريخيّ، يمكن إثبات خطإه انطلاقًا من أوضاع المسيحيّة عينها. ولكنّ مثل هذا الخطإ لا يجوز اجتنابه بأن تنسحبَ المسيحيّة من العالم. فبناء على مطلبها الشامل، عليها أن تبقى دومًا في خدمة الإنسان والعالم. وهي تقوم بهذه المسؤوليّة بالضبط من خلال التمييز الصحيح بين الله والعالم. وإنّها، إذ تنـزع عن الإنسان عبء الرغبة في أن يصير إلهًا، هذا العبء الذي يستحيل عليه تحمّله، تحرّره في الوقت عينه ليقومَ كإنسان بالأعمال الإنسانيّة. ولأنّ المسيحيّة هي بالضبط شكر (إفخارستيّا) لله، فهي أيضًا مسؤوليّة من أجل عالم إنسانيّ.
3-2. تاريخ الإنسان مع الله: تاريخ الخلاص
في الارتباط الوثيق باختبار الواقع على أنّه خلق، يقوم الاختبار الثاني، وهو اختبار الواقع على أنّه تاريخ الله مع الإنسان. المصطلَح المستعمل لهذا الاختبار هو تاريخ الخلاص. غير أنّ هذا التعبير غامض، ولذلك لا يحبّذ الكثيرون استعماله؛ ولكن لم يُقترَح إلى الآن مصطلح أفضل وأقلّ غموضًا. غير أنّ المهمّ ليس المصطلح نفسه بقدر ما هو اختبار الإيمان الذي يحاول وصفه. إنّ الله، بصفته سيّد الكون الحرّ، لا يُختبَر في العهد القديم والعهد الجديد من خلال نظام للكون مؤسّس في بدء الزمن وثابت كما هو بصورة دائمة؛ الأمر الحاسم بالنسبة إلى الإيمان الكتابيّ ليس الكون والطبيعة، إنّما هو اختبار قيادة الله في التاريخ. الله ليس البعد العميق للكون الحاضر في كلّ زمان ومكان، ولكن غير الممكن إدراكه واقعيًّا في أيّ مكان؛ بل يعتلن بالحريّ في انعطاف أصيل وحرّ من خلال ما يقوم به في التاريخ من اختيار ودعوة، ومن مغفرة ودينونة. والإنسان، في التقائه إله التاريخ هذا، اختبر ذاتَه أنّه مختار ومدعوّ ومرسَل قد ألقيت عليه مسؤوليّة تاريخيّة. وبالتالي فإنّ مقولات حريّة كلّ إنسان، والمسؤوليّة، والشخص، والفرد، والفرادة والنهائيّة في التاريخ، قد تمّ تصوّرها أوّلاً على قاعدة التاريخ المسيحيّ للخلاص.
بيد أنّ المسيحيّة لا تضع نصب عينيها الفرد المنعزل والمشتّت. فالكتاب المقدّس ينظر إلى الإنسان دومًا في تداخلاته مع البشريّة جمعاء ومع تاريخها. حتّى في لقائه بالله في الخلاص والهلاك، لا يبدأ الإنسان الفرد أبدً من النقطة الصفر؛ بل يقوم بالحريّ في ترابط متضامن من الخلاص والهلاك مع جميع الناس. والمقولات مثل الخطيئة الأصليّة، وقيامة الجسد العامّة، ودينونة العالم، يجب فهمهما في هذا الارتباط. إنّ مصطلح الخطيئة الأصليّة الغامض لا يعني وراثة بيولوجيّة تسم أفرادًا منعزلين في سائر الأمور؛ فالمقصود بهذا المصطلح هو إ ثبات ارتباط حريّة كلّ إنسان بوضع معيَّن، بمعنى أنّ الإنسان الفرد لا يرسم خطوط حياته ولا يضع شكلها بصورة مستقلّة تمامًا، إنّما هو متعلّق بمجمل تاريخ خطيئة البشريّة. والتضامن في الهلاك يقابله التضامن في الخلاص. فدعوة إبراهيم نفهسا تتضمّن بركة لجميع الشعوب. وقد فهم إسرائيل اختياره بأنّه دعوة إلى تمثيل جميع الشعوب. والمسيحيّون ليسوا مرشّحين أصحاب امتياز للخلاص؛ فأن يكونَ الإنسان مسيحيًّا يعني بالحريّ أن يكون مرسلاً ليُسهِم في خلاص العالم.
من كلّ هذا تنتج نظرة للواقع، لا تحدّدها أنظمة أزليّة تسير الطبيعة بموجبها، بل تتكوّن بالحريّ من خلال تاريخ اللقاء بين الله والناس. وهذا التاريخ لا يسيطر على البشريّة مثل قدَر مأسويّ مشؤوم؛ إنّه تاريخ الذنب والنعمة والدينونة والمغفرة. ومن ثمّ فتاريخ الله مع الناس، ولا سيّما التاريخ الذي يسير من العهد القديم إلى العهد الجديد، ليس تاريخ تقدّم في خطّ مستقيم تصاعديّ. هذا المفهوم الحديث للتاريخ يعود بلا شكّ إلى المصادر الكتابيّة، ولكنّه يحوّل هذه المصادر إيديولوجيًّا أو ماديًّا إلى نوع من تاريخ الطبيعة. إنّ تواصل التاريخ، من وجهة النظر المسيحيّة، يرتكز فقط على أمانة الله الخالقة، ضمن عدم أمانة الناس ورغم عدم الأمانة هذا. من هنا ينتج مفهوم للتاريخ يمكن وصفه بالنموذجي: إنّ الاختبارات الحاضرة والماضية تبيّن كما في مرآة أو كما في ظلال ما يمكن أن نرجوَه للمستقبل؛ وهكذا ثمّة مقايسة بين التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل.
إنّ أقوال المسيحيّة بشأن أمور الآخرة يجب أيضًا فهمها انطلاقًا من المقابلة مع ما جرى إلى الآن من تاريخ الله مع الناس. إنّها ليست تحقيقات صحفيّة مسبقة، بل أقوال رجاء بالنظر إلى محبّة الله التي اختبرناها بصورة نهائيّة في شخص يسوع المسيح. ومن ثَمّ لا يتوجّه رجاء المسيحيّ إلى مستقبل (futurum) الإمكانيّات الموضوعة في الواقع، بل إلى المجيء (adventus) النهائيّ لملكوت محبّة الله. هذا الرجاء يمنع التفكير في عاقبة مزدوجة للتاريخ بالنسبة إلى الخير والشرّ. ولكن من جهة أخرى فإنّ التفكير في مصالحة كلّ الكائنات بصورة رخيصة يُعارض التاريخ. بالنّظر إلى يسوع المسيح، الذي اتّخذ الدينونة على عاتقه ممثّلاً الجميع، يستطيع المسيحيّ أن يرجو أنّ ملكوت الله سوف يجلب الخلاص لجميع الناس. مثل هذا الرجاء المتّجه إلى يسوع المسيح هو رجاء يمثّل تمثيلاً فعّالاً رجاء جميع الناس.
النظرة التاريخيّة إلى الواقع تعني بالنسبة إلى المسيحيّة حافزًا دائمًا لتحمّل المسؤوليّة في التاريخ. فلأنّ المسيحيّ يرجو كلّ شيء من الله، من أجل ذلك عينه يستطيع بفضل هذا الرجاء أن يفعل كلّ شيء للاخرين. وبالتالي فالمسيحيّة ليست ديانة عمل باطنيّ محض. إنّها من جوهرها تنطوي على بُعْد سياسيّ. أمّا إلى أيّ مدى يمكن استخلاص لاهوت سياسيّ من هذا البُعْد، فهذا موضوع خلاف وجدَل (ميتس J. B. Metz ومولتمن (J. Moltmann. يجب بالحريّ أن نرى الأهميّة السياسيّة للمسيحيّة في نقد كلّ لاهوت سياسيّ. فلأنّ المسيحيّة ترى كلّ التاريخ في ظلّ ملكوت الله، يتوجّب عليها أن تعارض كلّ محاولة يقوم بها أيّ شعب أو طبقة أو عرق أو فريق لينصّب نفسه سيّد التاريخ وفاعل التاريخ الشامل. وكذلك يجب على الكنيسة الاّ تخطأ فتعتبرَ ذاتَها حكومة إلهيّة. مع هذا التدمير النقديّ الإيديولوجيّ لكلّ ادّعاء سياسي مطلق تُسهم المسيحيّة في أنسنة السياسة. فبقولها إنّ اكتمال التاريخ النهائيّ ليس عملاً يمكن صنعه تاريخيًّا، تصون حريّة الفرد، الذي لا يستمدّ كرامته ممّا يستطيع نظام سياسيّ القيام به، بل من الله وحده. ولكنّ حريّة الله والحريّة أمام الله هما حريّة الجميع في التضامن. ومن ثمّ فإنّ حريّة الفرد لا يمكن تحقيقها إلاّ في نظام تضامني للحريّة. مع هذا الموقف الذي يتجاوز الاختيار بين الفردانيّة والجماعيّة، تملك المسيحيّة موهبة اجتماعيّة خاصّة، تلتزم استنادًا إليها إقامة العدل والسلام في العالم. المسيحيّة، بحسب المجمع الفاتيكاني الثاني، هي علامة وحدة جميع الشعوب والأعراق والطبقات وسرّ هذه الوحدة. ولذلك فالبشارة المسيحيّة بالمحبّة ليست بديلاً عن العدل، بل هي اكتماله الفائق.
3-3. عقيدة الفداء
إنّ اختبار الحريّة التي لا يمكن تقديرها في العلاقة بين الله والإنسان في التاريخ يؤدّي إلى اختبار أساسيّ ثالث للإيمان المسيحيّ، يمكن وصفه باختبار النـزوح. وقد توسّعت فيه عقيدة الفداء المسيحيّة. لقد اختُبر الفداء في العهد القديم أصلاً كتحرير من ضيق واقعيّ. ففي بداية تاريخ الخلاص الكتابيّ يقوم نزوح إبراهيم من أرض آبائه. وإنّ التحرير أو النـزوح (الخروج) من عبوديّة مصر يعبتره العهد القديم عمل الفداء العظيم الذي أجراه الله؛ وقد صار في كرازة الأنبياء نموذجًا للتحرير في نهاية الأزمنة. وفي العهد الجديد صار عبور الأحمر صورة للفصح، أعني عبور يسوع من خلال الموت والقيامة. والمسيحيّ يؤمن بأنّه من خلال المعموديّة يندرج في هذا الحدث ويُحرَّر من سلطة الخطيئة والموت. ولتفسير هذا الفداء بما يعنيه من تحرير، عُرضت في الكتاب المقدّس كما في التقليد اللاهوتي تصوّرات عن التكفير والذبائح مستقاة من تصوّرات مشتركة بين مختلف الأديان. ولكن في الوقت عينه تمّ إصلاحها. فبحسب الاعتقاد المسيحيّ لا يتعلّق الموضوع في الفداء بإقامة نظام من تبادل الإنجازات، بل بالتحرير من شريعة إنجازات من هذا النوع. إنّ رسالة الفداء المسيحيّة لا تُعتبر شريعة بل هي إنجيل يحرّر متجاوزًا الشريعة من خلال المحبّة.
البرّ، أي النظام القويم بين الله والإنسان، لا تمكن إقامته، بحسب الاعتقاد المسيحيّ، من خلال نظام من الإنجاز والإنجاز المقابل. إنّ اختبار النـزوح هو اختبار ما هو دومًا أعظم، وما يفوق دومًا كلّ شيء، وما هو دومًا جديد في محبّة الله. ولا يعطي الإنسان هذا الاختبار حقَّه إلاّ إذا تخلّى عن كلّ حساب وتنازل عن كلّ مطلب. هذا هو المعنى الأصلي لمصطلح "الإيمان" الكتابي. المقصود "بالإيمان" هو الموقف الذي لا يعتمد فيه المرء على إنجازاته الخاصّة ولا على قدرته الخاصّة بل يضع اتكاله التامّ على الله، ويقدّم له المجدَ ويرى فيه أساس وجوده. مثل هذا الإيمان الذي يتخلّى عن كلّ المعايير الدنيويّة هو الجواب الوحيد الموافق عن اختبار محبّة الله، هذا الاختبار الذي يحطّم كلّ المعايير، ويحرّر الإنسان من حيّز أنانيّته الضيّق ومن قلق الحياة الذي يساوره لتأمين نفسه، ويفتح له مستقبلاً جديدًا في محبّة تعطي ذاتها حتّى الموت. وبالتالي فإنّ موضوع الزيادة والفيض هو التحديد الحقيقيّ لتاريخ الخلاص (راتسينغر J. Ratzinger).
هذه الشريعة الأساسيّة للاكتمال الفائق يعبّر عنها بطريقة فريدة صليب المسيح وقيامته. على الصليب تظهر طاعة يسوع التي بها يتخلّى عن ذاته ويجيب عن محبّة الآب التي بها يتجرّد عن ذاته. إنّ فعل الطاعة البشريّة، الذي، في أقصى العجز، يحتمل بثبات التخلّي الإلهيّ، هو في الأساس الثغرة التي تنسكب فيها قدرة محبّة الله المحجوبة في نقيضها لتحقّق نهائيًّا الملكوت في التاريخ. ولذلك لا يمكن وصف هذا الحدث بالأسطورة، لأنّ مجيء محبّة الله النهائيّ لا يتحقّق إلى جانب التاريخ، بل في طاعة بشريّة تامّة. إنّ العقيدة الكلاسيكيّة القائلة بطبيعتين في شخص يسوع المسيح الإلهيّ الواحد قد أوضحت هذا الحدث بدقّة كبيرة، وإن بدت غامضة على نحو ما بالنسبة إلينا اليوم. ولذلك يحاولون اليوم، بخلاف اللاهوت التقليديّ، ألاّ يصفوا هذا الحدث بمقولات الفلسفة اليونانيّة والمدرسيّة، بل بمقولات تستند إلى العلاقة والشخص. وهكذا يصير الصليب والقيامة النموذج الفريد والنهائي للشريعة الأساسيّة في المسيحيّة، شريعة المحبّة التي تتجاوز نفسها، والتي تحرّر الإنسان ليتمّم بوجه فائق الشريعة في المحبّة.
3-4. الكنيسة
إنّ التاريخ الذي افتتحه يسوع المسيح لملكوت الله هو تاريخ فداء، أيّ أنّه واقع تاريخيّ محرِّر حيث يُقبل في الإيمان: أعني في الكنيسة، باعتبارها جماعة المؤمنين. الكنيسة، بحسب اعتقاد جميع الكنائس المسيحيّة، هي، من خلال كرازتها وأسرارها ومن خلال حياتها كلّها، ولا سيّما من خلال الأخوّة التي تسود فيها، المكان والعلامة لحضور روح المسيح. وباعتبارها جماعة في روح المسيح الواحد، لا تستطيع، بحسب جوهرها عينه، أن تكون إلاّ كنيسة المسيح الواحدة. ومن ثّمَ لا يسع المسيحيّة إلاّ أن تشعر بأنّ انقسامها إلى كنائس متعددّة تُقصي كلّ منها الكنائس الأخرى هو بمثابة شكّ.
التباينات الحاسمة بين الكنائس المسيحيّة ناجمة عن مفهوم مختلف للأقوال التي رسمناها آنفًا حول حضور واقع الفداء في الكنيسة. فالتقليد البروتستنتيّ يشدّد أكثر على انحجاب الكنيسة، والتقليد الكاثوليكيّ على طابعها المنظور (من خلال علامات الأسرار المنظورة). ومع ذلك لا تذهب الكنيسة الكاثوليكيّة إلى القول بالتماهي بين روح المسيح ومؤسّستها. هذا ما أوضحه بجلاء المجمع الفاتيكاني الثاني. ومن جهة أخرى لا تفصل العقيدة البروتستنتيّة الروح عن المؤسّسة. إنّ المصلحين قد ابتعدوا بصراحة عن هذه المحاولة التي يقوم بها بعض المندفعين، وربطوا بين روح الله "الكلمة والسرّ اللذين يعتلنان في الخارج". غير أنّ الكنائس البروتستنتيّة تؤكّد أكثر أنّ كلام الله وعمله يتمّان في التاريخ وفي الكنيسة حيث يشاء الله ومتى يشاء. أمّا الكنيسة الكاثوليكيّة فتتميّز بأنّها تؤكّد إلزاميّة مؤسّسة الكنيسة التاريخيّة، وعقيدتها، وأسرارها ووظائفها، وترى في هذا كلّه علامة لحضور الله وعمله في واقع التاريخ. لذلك يمكن وصف الأمر الحاسم المعاديّ كمبدإ لما هو كاثوليكيّ (شلير H. Schlier)، فيما يُعدّ تأكيد الحريّة المسيحيّة علامة مميّزة للبروتستنتيّة. ومع أنّه قد تمّ في العقود الأخيرة تخطّي كثير من الجدل وسوء الفهم، يبدو أنّه لا يزال قائمًا هنا خلال جدّي، يحول دون المشاركة الكنسيّة الكاملة في سرّ الإفخارستيّا.
الأرجح أنّ النـزاع بين الكنائس لن يُحَلّ من خلال محاولات انسجام مباشرة وأعمال منفردة. ربّما يُسهم في الحلّ التعميق لاختبار الروح القدس ولاهوت الروح القدس. وهذه هي الطريق الفضلى للتقرّر أيضًا من كنائس الشرق. فالروح القدس هو رباط المحبّة التي تشمل الوحدة والتنوّع، والتي تعني الارتباط في الحريّة والحريّة في الارتباط. إنّه الأساس الأخير والتعبير الأكثر إيجازًا لشريعة الاكتمال الفائق في المحبّة. انطلاقًا من لاهوت لروح المسيح الفعّال في الكنيسة، يجب التغلّب على الخلافات بين الكنائس وفي الوقت عينه الحفاظ على رغباتها المبرَّرة. وهذا لا يعني أنّه يمكن أن تنشأ في المستقبل، في عصر يمكن على ما نرجو أن يعقبَ تعدّد الكنائس، كنيسة الروح المحض. إنّ تخطّي الحرف نحو الروح يجب بالحريّ القيام به من جديد باستمرار، والتوتّر بين المحافظة والتجديد، وبين الموهبة والمؤسّسة يجب احتماله من جديد باستمرار. هذا النـزوح الدائم هو وحده كفيل بأن يفسح في المجال للكنيسة لتنسجم مع شريعة المحبّة الفائقة.
4. علاقة الكنيسة بالأديان الأخرى
مثل هذا النـزوح مطلوب في الانقلاب الحاضر للكنائس المسيحيّة ليس فقط للتغلّب على الخلافات القائمة بين الكنائس نفسها، بل أكثر من ذلك على المستوى العالميّ في اللقاء مع ثقافات الشعوب الأخرى وأديانها. إنّ شموليّة الرسالة المسيحيّة تمنع أن ترى في هذه الأديان مجرّد زور وكذب وبهتان، وأن تُغفل أنّها تتضمّن آثارًا وأجزاء من حقيقة الله (بذور الكلمة). "في سعي البشريّة المتلمّس نحو الله يحيا سعي الله المتلمّس نحو البشريّة" (التعليم المسيحيّ الهولندي). المسيحيّة، استنادًا إلى نظرتها في تاريخ الخلاص، تكتشف في الأديان من جهة الانحرافات التي يتعرّض لها الله والإنسان وتنتقدها؛ ومن جهة أخرى ترى فيها أيضًا علامات مشيئة الله الخلاصيّة الشاملة، وقيادته للتاريخ وعلامات فعّاليّة الروح القدس. إذ إنّ "كلّ حقيقة، مهما كان من يكرز بها، تأتي من الروح القدس" (القدّيس أمبروسيوس). لذلك ثمّة، بحسب الاعتقاد المسيحيّ، إمكانيّة خلاص موضوعيّة لكلّ إنسان يتمّم مشيئة الله كما يحدّدها له ضميره في مختلف أوضاع حياته الواقعيّة. في هذه العلاقة بالأديان وفي ما تحويه من قبول ورفض (فريس H. Fries )، تعتبر المسيحيّة ذاتها كمال الأديان الفائق. ولكنّ المسيحيّة نفسها لا تستطيع هي أيضًا أن تصل إلى "ملئها" في واقع التاريخ إلاّ إذا تخطّت شكلها الذي لا يزال إلى الآن غريبًا إلى حدّ بعيد، لتتقبّل في ذاتها غنى الشعوب وأديانها.
في هذه العلاقة الواسعة يمكن فقط أن يُفهم صحيحًا مطلب المطلقيّة الذي هو موضوع خلاف وجدل كبيرين. هذا المصطلح الكثير الغموض لم يصدر عن اللاهوت المسيحيّ بل عن الفلسفة المثاليّة. ولذلك لا يجوز استعماله إلاّ مع تفسير لاهوتي جديد. المقصود به هو أنّ المسيحيّة تكتشف في يسوع المسيح الوحي النهائيّ والذي لا يمكن تجاوزه جوهريًّا والشامل، الذي به كشف الله عن محبّته لجميع الناس. هذا المصطلح، في مفهومه الصحيح، لا يتضمّن إذن أيّ تعصّب ضيّق أو تزمّت، بل بخلاف ذلك وعدًا للجميع وبالتالي التزامًا بخدمة الجميع. يُعترف اليوم عمومًا أنّ هذه النظرة تستتبع تغييرًا في ممارسة الرسالة في جميع الكنائس، لتتّخذ الرسالة شكلاً أكثر حوارًا. فالموضوع في الرسالة لم يعد يتعلّق بإنقاذ "أنفس" منفردة، ولا بالأحرى بمجرّد انتشار الكنيسة. المسألة هي بالحريّ مسألة انغراس المسيحيّة. وهذا يعني أكثر من تكييفات منهجيّة تربويّة؛ فالأمر يتعلّق بمسيرة مبدعة، يمكن أن ينشأ فيها، في طريقة مبتكرة، وجه جديد للمسيحيّة أعني مسيحيّة هنديّة وصينيّة وأفريقيّة. في مثل هذا التلاقي الخلاّق مع الشعوب وأديانها، تستطيع المسيحيّة أن تُسهم في المصالحة والسلام بين الشعوب.
ما هي إذن المسيحيّة؟ في الختام أيضًا لا نستطيع أن نحصر جوهرها في تحديد. التحديدات من ذاتها تصف حتمًا وقائع. بيد أنّ المسيحيّة توصف من خلال موضوع الزيادة والفيض ومن خلال شريعة الاكتمال الفائق. الإله المسيحيّ ليس ضروريًّا، ولكنّه أكثر من ضروريّ (يونغل E. Jüngel). المسيحيّة، بالضبط في استحالة تحديدها، هي العلامة المَعَاديّة لحريّة الله في المحبّة، تلك الحريّة التي تفوق كلّ شيء. والمسيحيّة، بكونها تلك العلامة، عليها أن تبرهن عن ذاتها بمساعدتها في عالم متغيّر على تحقيق الوحدة في الكثرة، والحريّة في الارتباط، والعدل من خلال المحبّة. ولكونها الاعتراف بمحبّة الله التي تفوق كلّ شيء والتي اعتلنت من خلال يسوع المسيح، تقدم على الخدمة باهتمام يفوق كلّ حقّ وكلّ عدل لقيام عالم أكثر إنسانيّة. بدل أن نحدّد جوهرها، علينا أن نحاول أن نرويَ بطريقة حيّة تاريخها الذي يتجاوز دومًا ذاته، ونعمل اليوم على تحقيقه.
جدول زمني
حوالى 6/7 قبل المسيح حتّى
30 بعد المسيح : حياة وأعمال يسوع المسيح
انطلاقًا من حوالى سنة 32 : عمل وأسفار الرسل بولس الرسوليّة
حوالى 48/49 : "مجمع الرسل" في أورشليم: التحرّر من الشريعة اليهوديّة
حوالى 64-67 : استشهاد الرسولين بطرس وبولس في رومة
حوالى 150 : إتمام تكوين العهد الجديد
القرن الثالث والرابع : عصر اضطهادات المسيحيّين الكبرى
313 : قرار ميلانو على يد قسطنطين: المسيحيّة دين مسموح به
325 : المجمع المسكونيّ الأوّل في نيقية: يسوع المسيح إله حقّ
380 : قرار ثيوذسيوس: المسيحيّة دين الدولة
451 : المجمع المسكونيّ الرابع في خلقيدونية: يسوع المسيح إله حقّ وإنسان حقّ
حوالى 480-547 : بندكتُس من نورسيا: مؤسّس الرهبانيّة الغربيّة
754 : تتويج ببيان القصير إمبراطورًا – نشأة الدولة البابويّة
800 : تتويج شارل الكبير إمبراطورًا للغرب: بدء الإمبراطوريّة الرومانيّة الجرمانيّة المقدّسة
1054 : الانفصال النهائيّ بين الكنيسة البيزنطيّة والكنيسة الرومانيّة
1077-1122 : الجدل حول الحقّ في تعيين الأساقفة في الغرب
1096-1270 : عصر الحملات الصليبيّة
1215 : المجمع اللاترانيّ الرابع: قمّة توسّع السلطة البابويّة
1309-1377 : منفى باباوات في أفينيون- فرنسا
1378-1417 : الانشقاق الكبير في الغرب
1517 : نزاع الغفرانات وبدء الإصلاح على يد مارتن لوتر
1522 : الإصلاح في تسوريخ على يد تسْفنغلي
1536-1564 : الإصلاح في جنيف على يد كَلْفين
1545-1563 : المجمع التريدنتيني: تحديدات ضدّ الإصلاح، وإصلاح ذاتيّ للكنيسة الكاثوليكيّة
1555 : سلام أوغسبورغ الدينيّ
1869-1870 : المجمع الفاتيكاني الأوّل: أوّليّة البابا وعصمته
1875 : إنشاء الرابطة العالميّة للإصلاح
1927 : مؤتمر الكنائس العالميّ الأوّل: اجتماع هيئة "الإيمان والنظام" في لوزان- سويسرا
1947 : إنشاء الرابطة العالميّة اللوتريّة
1948 : الجمعيّة العامّة الأولى لمجلس الكنائس العالميّ في أمستردام – هولندا
1961 : المؤتمر الأرثوذكسيّ العامّ في رودس – اليونان
1962-1965 : المجمع الفاتيكاني الثاني: تجديد الكنيسة الكاثوليكيّة الداخلي وانفتاحها المسكونيّ
المراجع
G. Ebeling, Das Wesen des christlichen Glaubens, Tübingen 1959.
Evangelischer Erwachsenenkatechismus. Kursbuch des Glaubens. Im Auftrag der Katechismus-Kommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, hrsg. von W. Jentsch, H. Jetter, M. Kiessing und H. Reller, Gütersloh 1975.
R. Guardini, Das Wesen des Christentums, Würzburg 51958.
Katholischer Erwachsenenkatechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche, hrsg. von der Deutschen Bichofskonferenz, Limburg u.a. 1985.
تُرجم هذا الكتاب إلى اللغة العربيّة بعنوان: التعليم المسيحيّ الكاثوليكيّ للبالغين: المسيحيّة في عقائدها، نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانية، نقله المطران سليم بسترس، سلسلة الفكر المسيحيّ بين الأمس واليوم، رقم 18، المكتبة البولسيّة، جونية – لبنان، 1998.
W. Kasper, Einfürung in den Glauben, Mainz 71983.
W. Kasper, Jesus der Christus, Matthias-Grünewald Verlag, Mainz 1992.
تُرجم هذا الكتاب إلى اللغة العربيّة بعنوان: يسوع المسيح، نقله المطران يوحنّا منصور، سلسلة الفكر المسيحيّ بين الأمس واليوم، رقم 23، المكتبة البولسية، جوينة – لبنان، 2000.
A. Kallis, Orthodoxie – was ist das? Mainz 1979.
H. Küng, Christ sein, München 1980.
H. Küng u.a. Christentum und Wertreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus, München 1984.
J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, München 1972.
Neues Glaubensbuch, hrsg. von Feiner und Vischer, Der gemeinsame christliche Glaube, Freiburg i. Br. 21973.
K. Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Müchen 1976, 111979.
J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, München, 121977.
تُرجم هذا الكتاب إلى اللغة العربيّة بعنوان: جوزيف راتسنجر، مدخل إلى الإيمان المسيحيّ، ترجمه إلى العربيّة الدكتور نبيل خوري، سلسلة الفكر المسيحيّ بين الأمس واليوم، رقم 15، المكتبة البولسيّة، جونية – لبنان، 1994.