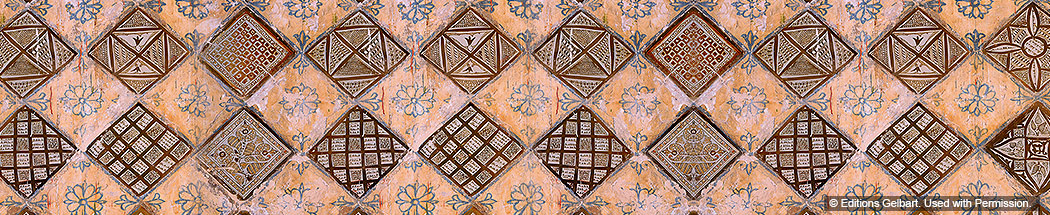قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
هم الإسماعيلية، وإنّما لُقّبوا بهذا اللّقب لحكمهم بأنّ لكلّ ظاهرٍ باطنًا، ولكلّ تنزيلٍ تأويلاً. ولهم ألقاب كثيرة غير هذه، على حَسب البقاع التّي نشأوا بها والمقالات التي دعوا إليها. فهم بالعراق يُسَمّون الباطنية والقرامطة والمزدكية، وبخراسان يسمّون التعليمية والملحدة. وهم يقولون: "نحن إسماعيلية لأننّا تميّزنا من فرق الشّيعة بهذا الإسم وهذا الشّخص". والباطنية الأولى قد ألفوا لهم مذهبًا خلطوا فيه بين الفلسفة والتّصوف وصنّفوا فيه كُتُبًا كثيرةً، ولهم علماء وأئمّة مشهورون. قالوا في الخالق: "إنه موجود ولا عالم ولا قادر، إلخ". فإن الإثبات الحقيقيّ يقتضي شركةً بينه وبين سائر الموجودات. فلم يمكن الحكم بالإثبات المُطلق والنّفي المُطلق، بل هو إله المُتقابلين وخالق الخصمين والحاكم بين المتضادين. وروُوا عن محمد بن علي الباقر أنه قال: "لما وهب اللّه العلم للعالمين قيل هو عالم؛ ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر. فهو عالم وقادر بمعنى أنّه وهب العلم والقدرة". وقالوا "كذلك نقول في القِدَم إنّه ليس بقديمٍ ولا محدثٍ بل القديم أمره وكلمته، والمُحدث خلقه وفطرته، أبدع بالأمر العقل الأوّل الذي هو تام بالفعل، ثم بتوسّطه أبدع النّفس الثاني الذي هو غير تامٍ. ونسبة النفس إلى العقل، إمّا نسبة النّطفة إلى تمام الخلقة والبيض إلى الطّير؛ وإمّا نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المُنتج؛ وإمّا نسبة الأُنثى إلى الذّكر والزّوج إلى الزّوج.
قالوا: ولما اشتاقت النّفس إلى كمال العقل واحتاجت إلى حركةٍ من النّقص إلى الكمال، احتاجت الحركة إلى آلة الحركة، فحدّثت الأفلاك السّماوية وتحرّكت حركةً دوريّةً بتدبير النّفس، وحدّثت الطّبائع البسيطة بعدها، وتحرّكت حركةً استقامت بتدبير النّفس أيضًا؛ فتركّبت المركبات من المعادن والنّبات والحيوان والإنسان، واتّصلت النّفوس الجزئية بالأبدان. وكان نوع الإنسان متميّزًا عن سائر الموجودات بالإستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار. وكان عالمه في مقابل العالم العُلويّ عقل ونفس كليّ. ووُجِبَ أن يكون في هذا العالم عقل شخص هو كلّ، وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ يسمّونه الناطق وهو النبي ونفس مشخّصة هو كلّ أيضًا، وحكمها حكم الطفل النّاقص المتوجّه إلى الكمال أو حكم المنطقة المتوجّهة إلى التّمام أو حكم المُزدوج بالذكر ويسمونه الأساس. وقالوا كما تحرّكت الأفلاك بتحريك النّفس والعقل والطّبائع، كذلك تحرّكت النّفوس والأشخاص بالشّرائع بتحريك النبي والوصي. وفي كل زمانٍ دائر سبعة سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التّكاليف وتضمحلّ السُّنن الشّرعية لتبلغ النّفس إلى حال كمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به ووصولها إلى مرتبته فعلاً وذلك هو القيامة الكبرى. فتنحلّ تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات، وتنشقّ السّماء وتتناثر الكواكب وتبدّل الأرض غير الأرض وتُطوَى السّماوات كطيّ السّجل للكتاب المرقوم فيه ويُحاسب الخلق ويتميّز الخير عن الشر والمطيع عن العاصي وتتّصل جزئيات الحق بالنّفس الكُليّ وجزئيات الباطل بالشّيطان المُبطل. فمن وقت الحركة إلى السّكون هو المبدأ، ومن وقت السكون إلى ما لا نهايةٍ له هو الكمال. ثم قالوا ما من فريضةٍ وسنةٍ وحكمٍ من أحكام الشّرع من بيع وإجارة وهبة ونكاح وطلاق وجراح وقصاص ودّية إلاّ وله ما يقابله من العالم عددًا في مقابلة حَكمٍ. فإن الشّرائع عوالم روحانية أمرية والعوالم شرائع جسمانية خلقية، وكذلك التّركيبات في الحروف والكلمات على ما يقابله من تركيبات الصّور والأجسام والحروف المُفردة، نسبتها إلى المركّبات من الكلمات كالبسائط المجرّدة إلى المركبات من الأجسام. ولكلّ حرفٍ وزان في العالم وطبيعة يخصّها وتأثير من حيث تلك الخاصية في النفوس. فعن هذا، صارت العلوم المُستفادة من الكلمات التّعليمية غذاء للنفوس، كما صارت الأغذية المستفادة من الطّبائع الخُلقية غذاء للأبدان. وقد قدّر اللّه أن يكون غذاء كلّ موجود بما خلقه منه. فعلى هذا الوزان صاروا إلى ذكر أعداد الكلمات والآيات، وأن التّسمية مُركّبة من سبعة واثني عشر وأن التّهليل مركّب من أربع كلماتٍ في إحدى الشّهادتين وثلاث كلمات في الشّهادة الثانية وسبع قطع حرفًا في الثانية، وكذلك في كلّ آية أمكنهم استخراج ذلك.
وقد وضعوا في ذلك كُتبًا ودعوا أئمّتهم الذين هم عَرَفَة هذه الرسوم وكَشَفَة هذه المساتير. ثم لما أظهر الحسن بن الصّباح دعوته، ترك أحزابه هذه الدّعاوى وقصّروا دعوتهم إلى اتّخاذ إمامٍ صادقٍ معصومٍ في كلّ زمانٍ، وتعيين الفرقة النّاجية من فرق المُسلمين. وكان باطن الأمر قلب الحكومة والإستبداد بها. ولأجل نيل مأربهم عمدوا إلى المقاتلة، فصعد رئيسهم إلى قلعة الموت بالعراق وتحصّن بها سنة 383 هـ. وكان من أمرهم ما كان من العبث بالنّظام والعبث بالرّاحة العامة، حتى انتهى أمرهم بالإضمحلال.