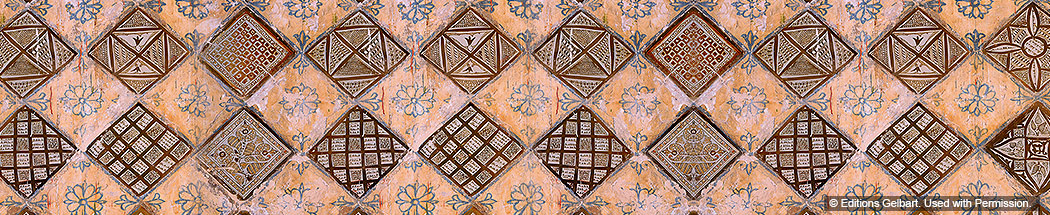قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
بقلم د.. نقولا زيادة في كتابة "في سبيل البحث عن الله" الصادر عن الأهلية للنشر في بيروت.
" في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية، قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات. فإن هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة" (متى 1:3-3). وهذا الذي أشير إليه هو المسيح، الذي جاء يدعو الناس إلى دين يختلف عن اليهودية، ولو أنه هذا لم يتضح تماماً أول الأمر.
تتصدر أخبار الأجزاء الأولى من العهد الجديد وهي الأناجيل: إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. والباحثون متفقون، تقريباً، على أن الأناجيل الثلاثة الأولى كتبت بين سنتي 65 و90م، وأن إنجيل يوحنا كتب بين سنتي 110 و125م، وأن أول الأناجيل زمناً هو مرقس.
وإلى الأناجيل الأربعة فإن العهد الجديد، وهو الجزء الخاص بالمسيحية من الكتاب المقدس، يحتوي على أعمال الرسل ومجموعة من الرسائل التي وجهها بولس الرسول وبطرس وغيرهما من المرسلين المبشرين بالمسيحية. وهناك أخيراً سفر رؤيا يوحنا. وقد كتبت الأناجيل أصلاً باللغة اليونانية ومثلها بقية العهد الجديد. ويبدو، من التقصي التاريخي، أن الأناجيل قد قبلت قانوناً في القرن الثاني، أما ما تبقى فلم يثبت "قانوناً" إلا في القرن الرابع.
والدعوة التي حملها المسيح إلى البشرية هي لجميع البشر، ولم تكن مثل الدعوة اليهودية موجهة إلى شعب معين مختار. وفيها أن الملكوت السماوي هو ملكوت الله، وأن الله هو الذي يهبه للبشر. وقبول هذا الملكوت يتم بالتوبة التي هي الولادة الثانية.
وليس من شك في أن لليهودية بقايا عرفت في المسيحية. لكن في نهاية المطاف كانت المسيحية ثورة على ما تمثله اليهودية. فهذه كانت مقيدة بتقاليد وطقوس وتشريعات كثيرة، أي أنها كانت ديانة طقسية؛ أما المسيحية فأساسها الطهارة القلبية والإيمان الذي تحتضنه الروح والقلب النقي. والطقوس على تنوعها، مثل التنظيم الكنسي كان أمراً مكتسباً.
وحري بالذكر أن هناك من حسب، أول الأمر، وفي بيت المقدس خاصة، أن المسيحية كانت فرقة يهودية جديدة، على نحو ما كان قد ظهر في القرن الأول قبل الميلاد من فرق مثل الصدوقيين والفريسيين. وظل هذا الأمر شائعاً حتى هدم تيطس الهيكل سنة 70م، وعندها اتضح للجميع أن المسيحية ليست فرقة يهودية أخرى لأن المسيحيين لم يشكوا من هذا التدمير.
أما في إنطاكية خاصة، وفي مدن أخرى من سورية وشرق الأردن حيث كانت الحضارة الهلنستية قد تجذرت خلال القرون الثالثة بين الإسكندر والمسيح، فلم ينظر إلى المسيحيين على أنهم "يهود جدد" بل على أنهم جماعة يتحدثون بلغة جديدة ويدعون إلى آراء جديدة، لكنها ليست ذات قيمة، في رأي معاصريهم.
والمسيحية، في القدس وفي إنطاكية وفي سواهما، قبلت أن المسيح ولد منمريم العذراءوصلب وقبر وقام من بين الأموات. واعترف الجميع بالروح القدس وقبلوا بالعماد والعشاء السري المقدس الذي تمثله الشركة وهي تناول الخبز والخمر باعتبارهما ممثلين لجسد المسيح ودمه، وذلك عند القيام بالقداس الروحي. قد تكون بعض من هذه سبق البعض الآخر من حيث القبول أو الممارسة، لكن هذه هي المظاهر والعقائد الرئيسة التي كانت تميز المسيحيين عن غيرهم. وكثيراً ما كانوا يمارسون هذه الأشياء في أماكن سرية خشية التعقب والاضطهاد.
انتشرت المسيحية في القرن الأول، على يد تلاميذ المسيح والمبشرين بها، في المدن قبل الأرياف، وهي أجزاء من بلاد الشام قبل فلسطين، لأن اليهود كانوا يقاومونها هنا مقاومة شديدة. كما أن المسيحية انتشرت في مناطق واسعة وبين فئات من البشر كانت لها عبادات وفلسفات وحتى أساطير دينية وغير دينية متنوعة ومتباينة. وكانت لغات متعددة تستعمل في هذه الرقعة الواسعة التي هي الامبراطورية الرومانية وبعض الجوار، خاصة في الشرق. فالآرامية، التي تصبح السريانية بعد أن تتنصر، كانت مألوفة في مناطق متعددة، خاصة في أرض الرافدين وما جاورها من بلاد الشام وفي الأجزاء التي لم تتهلين من هذه البلاد. وكانت اليونانية لغة أهل المدن الشامية المتهلينة ولغة قبادوقيا وبلاد اليونان. كما أن اللاتينية كانت لغة المسيحيين المتعلمين في شمال أفريقيا (باستثناء مصر) وفي إيطاليا وبلاد الغال.
وليس من شك في أن استعمال اللغات المختلفة كان له أثر كبير في الخلافات التي قامت بين الفئات المسيحية، خاصة عندما كانت الأمور تختلط مع الآراء الفلسفية.
وعلى كل فإن الخصومة المسيحية ذر قرنها من أول الأمر وكان ذلك على أيدي اليهود، الذين لم يقبلوا بأنه المسيا (المشيح) المنتظر، واعتبروا أن المسيحيين فئة ضالة يجب مقارعتها وضربها. وكان هناك أصحاب المدارس الفلسفية الذين اعتبروا المسيحية أنها نزلت عن مستوى الفكر الفلسفي، ومن ثم فهي خطر على التطور الفكري للجماعات التي قد تقبلها. أما الخصم الأقوى فقد كان الدولة الرومانية نفسها. ذلك بأن المسيحيين رفضوا عبادة الامبراطور وروما وتقديم القرابين لهما، ثم رفضوا عبادة الشمس؛ وهاتان كانتا ديانتين رسميتين حاولت الامبراطورية، عن طريقهما، الواحدة بعد الأخرى، إيجاد عنصر روحي مشترك لشعوب الامبراطورية . فرفض المسيحيين للعبادة الرسمية اعتبر عصياناً على قوانين الدولة، ومن ثم فقد حق عليهم العقاب. وهذا هو الاضطهاد الرسمي الذي ظل المسيحيون يعانونه مدة طويلة وبأنواع مختلفة من التعذيب.
المهمات الأولى
شهدت القرون الثلاثة الأولى من انتشار المسيحية في المنطقة التي تعنينا تطورات مهمة كانت نتيجة التواصل النشيط بين أنحاء العالم المعروف من شواطئ المحيط الهندي وسواحل البحر المتوسط، العالم الذي كان قد قربت فيه المسافات وتنقل فيه التجار والرحالون بشكل لم يكن معروفاً من قبل. وقد أدى ذلك إلى اختلاط في الأعراق والآراء، فوصلت آراء هندية صوفية وفكرية إلى أماكن في حوض البحر المتوسط مثل الاسكندرية. فأصبحت المنظومة الفكرية التي قد يدعو إليها مفكر أو مدرسة تقوم على تركيب فلسفات أو آراء متعددة كي تنتهي إلى شيء جديد. ولعل الفلسفة الرواقية والأبيقورية من خير الأمثال على ذلك.
لكن الأمر المهم هو أن الجو كان فيه شيء جديد هو المسيحية، التي تختلف أساساً عن فلاسفة الأقدمين. وقد كانت ثمرة محاولة للتوفيق بين اليهودية والمسيحية، وذلك عن طريق تفسير بعض ما جاء في الأناجيل بالإشارة إلى ما جاء في العهد القديم. لكن هذه المحاولة لم تنجح لما اتضح للناس أن الفرق بين الكنسية المسيحية والكنيس اليهودي وما يمثلان، كبير جدا.
وكان هناك المذهب الغنوسي. وكان اتباع الغنوسية يرون أن العالم هو أصلاً من صنع إله آل على نفسه أن يمزج الإنسان الأبدي بعناصر الحياة الأخرى. وأن هذا الإله الذي سماه المسيح "أباه" هو القادر على إصلاح العالم. وهذا يتم متى جمع الرأي الهلينستي القائل بأن الكون هو فيض إلهي إلى ما جاء في الأناجيل. ففي بعض نواحيها على الأقل كانت الغنوسية محاولة توفيقية – تركيبية بين المسيحية والفلسفة أو الآراء.
وفي هذه الأجواء المتنوعة الاتجاهات ظل جماعة المؤمنين في أول الأمر على ولائهم للكنيسة الجامعة، وظل اعتمادهم على الأناجيل والرسائل. ومما حفظ للمسيحية الكنيسة الأم مكانتها هو أن الأساقفة الذين تولوا شؤونها كانوا دوماً قانونيين، أي أنهم كانوا مرسومين كهنة قبل أن يتولوا إدارة كنيسة أسقفية. فكانوا لذلك منضبطين.
قوي الأحياء الفلسفي الهلينستي في النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، وكان يحيط به إطار ديني مستمد من بعض الديانات القديمة. وليس غريباً أن يكون ممثل هذا الاتجاه أفلوطين (تو. 270) المصري المنشأ، الشامي الزيارة، الرومي الإقامة الذي تمثل ما لا يقل عن ثمانية قرون فلسفة الأغارقة وامتص بعض التصوف وتأثر بأفلاطون خاصة، ومن هنا سميت فلسفته الأفلاطونية الحديثة، ولو أن في التسمية بعض التجوز. واعتقد أفلوطين بأن الكون هو نتيجة عمل أو صنع تم على يد "الواحد" أو "الأحد"، وأن طريقة الخلق كانت الفيض، الفيض الأول من "الواحد" ثم فيض من فيض حتى تستكمل الحياة في عدد من هذه هو أما عشرة أو اثنا عشرة.
نبغ عدد من أصحاب الأقلام من المسيحيين الذين حاولوا توضيح المسيحية للآخرين مستعملين لغتهم. وبعض هؤلاء انتهى الأمر بهم إلى الاستشهاد في واحدة من موجات الاضطهاد التي كان الأباطرة الرومان يثيرونها، بين الحين والآخر، ضد هؤلاء المؤمنين بدين لا يناسب عبادة الأمبراطور. وبين هؤلاء يوستين النابلسي الأصل (105-165) وتتيان السوري من أهل القرن الثاني، والذي شن في سنة 160 حملة شعواء على الفكر اليوناني الوثني كما كان يراه.
وقد كان مجال التنافر والجدل بين المسيحية والآراء القديمة على أشده في الاسكندرية، لأنه كان فيها مدرسة هي بقية المنظمة البطلمية في البلاد، وكانت مركزاً لدراسة الفلسفة والعلوم القديمة. وكان للمسيحيين مدرسة في الإسكندرية كان يعلّم فيها اللاهوت والإنسانيات القديمة والعلوم والرياضيات. وأحبار هذه المدرسة هم الذين صاغوا القواعد الأولى للمسيحية بشكل منظم. وكان من كبار معلمي هذه المدرسة إقلمنضس (تو. 254م) وأريغون (تو.254م). ولما تركها هذا وانتقل إلى قيسارية في فلسطين أصبحت المدرسة تابعة للبطريركية، واتخذت صفة التعبير عن العقيدة الرسمية في بلدها، وفقدت دورها كمؤسسة مشرّعة الأبواب للتفكير المستقل.
وإقلمنضُس نظر في القضايا والمشكلات الفكرية المجردة والفلسفية والحياتية، وبحث في الأسئلة التي طرحها رجال الفكر اليوناني ثم بحث عن الأجوبة لجميع هذه القضايا فوجد أن القدامى أجابوا عليها من قبل عن طريق الأسطورة. ولكن هذه الوسائل لم تعد صالحة. الوثنية كانت قائمة وكانت تقاوم المسيحية، لكن حيوية الأولى امتصها ما كان في أساليبها وآرائها من تناقض وفي طرق بحثها من تضارب. لذلك يجب أن يلجأ "الفكر" إلى مصدر جديد للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الجدد وتلك التي طرحها القدامى من قبل. والمصدر الجديد هو المسيحية التي هي تتويج لأفضل ما عرفته المدنية الهلينستية، روحياً على الخصوص.
وأريغون هو تلميذ إقلمنضس وخليفته في مدرسة الإسكندرية، ثم مؤسس التعليم المسيحي في مدرسة قيسارية الفلسطينية، إن لم يكن منشء المدرسة أصلاً. كان هم الرجل أصلاً دراسة العهد القديم من الكتاب المقدس دراسة مقارنة مع أمور أخرى تدخل في الفهم اللاهوتي للمسيحية. وكان من كبار المعلمين والدارسين الوثنيين في ذلك الوقت كلسّوس الذي وضع سنة 180م كتاباً شنّع فيه على المسيحيين وكال لهم التهم جزافاً. وألقى على المسيحية المسؤولية في أنها زعزعت أسس الأمبراطورية الرومانية. وكان رد أريغون أن الدين الذي يعلم الأخلاق الرفيعة السامية والذي تحمّل أتباعه العذاب والسجن والشهادة لا يمكن إلا أن يكون صحيحاً صادقاً. وأمل أن يهدي إله المسيحيين أباطرة رومة إلى الطريق السوي فينضموا إلى أتباع التعاليم الصادقة.
وقد قيل عن أريغون أن قيادته وتعاليمه أدت إلى نضج كبير في الجماعات المسيحية. وبذلك تهيّأت لدورها الكبير لما اعترفت الإمبراطورية الرومانية بالكنيسة.
وما دمنا قد أشرنا إلى مدرستي الإسكندرية وقيسارية، فلنشر أيضاً إلى مدرسة أديسا (الرها)، التي كانت باهتماماتها اللاهوتية، المركز الأول للمسيحية الأرامية- السريانية. ومعلمو هذه المدرسة أغنوا المسيحية بما توصلوا إليه من آراء قيمة.
الخلاف العقائدي
تولى قسطنطين عرش الإمبراطورية من سنة 305 إلى سنة 337م، لكنه لم يكن مستقلاً بالحكم إلا خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة. وفي أيام قسطنطين تم الاعتراف بالمسيحية ديناً من الأديان الرسمية في الإمبراطورية الرومانية (312م).
وحري بالذكر أنه في أوائل القرن الرابع كانت المسيحية قد حققت انتشاراً واسعاً؛ فقد قدر أن ثلث سكان الإمبراطورية، في رقعتها الواسعة، كانوا قد اعتنقوا المسيحية.
كانت قد ظهرت بين سنتي 140 و250م، مؤلفات متعددة تتناول حياة المسيح وتحاول تفسير طبيعته. والكثير من هذه المؤلفات، إن لم يكن أكثرها، وضع باللغة السريانية وفي أديسا وجوارها، وقد كان الكثيرون من الكتاب، فضلاً عن اتباع المسيحية في هذه الديار، يغلب عليهم العنصر العربي. ومن ثم فقد ظهر في أوائل القرن الرابع منهجان لتفسير طبيعة المسيح الواحد هذا الذي ذكرنا والثاني يوناني. كان هذا يحاول أن يفسر الأمر على طريقة فيها الأثر اليوناني المنطقي العقلي، بحيث ينظر إليها، أي طبيعة المسيح، نظرة مجردة. أما التفسير العربي-السرياني فقد كان يرى الأمور من منطلق طبيعي مرتبط بما كانوا قد درجوا عليه من فهم الدين في تجاربهم الروحية الطويلة الأمد.
وكان ثمة دعوة تقدم بها آريوس (256-335م)، وهو ليبي الأصل اسكندري النشأة والدراسة. وكان عالماً في شؤون الدين والفلسفة. وقد دارت تعاليمه اللاهوتية حول واحدة من المشكلات اللاهوتية الكبرى في المسيحية. إنه كان قد قبل فكرة الأقانيم الثلاثة، لكنه قال بأن "الآب" وحده استحق لقب "الإله". أما الابن فلم يكن سوى إله ثانوي، لكنه تميز عن بقية المخلوقات في أنه كان صورة الأب في جوهره، وكان منزّهاً عن الخطيئة.
يخيل إلينا أن آريوس كان ينظر إلى المسألة من ناحية الثالوث المصري القديم: حوروس وإيزيس وأوزيريس، الذي كان فيه واحد فقط له موضع خاص، هو حوروس.
لكن أسقف الإسكندرية الكسندروس كان يرى، ولم يكن منفرداً في الرأي، أن الابن مساو للآب في الجوهر. ولما عقد مجمع من المتقدمين في كهنة مصر، وعرض الأمر عليهم، بعد أن كان آريوس قد رفض أن يتقيد بآراء الأسقف في تعليمه، حرم (قطع) المجمع آريوس. فخرج آريوس إلى قيسارية فلسطين وكان أسقف المدينة ميالاً لوجهة نظر آريوس فشجعه على نشر آرائه. وانتقل آريوس إلى نيقوميدية (في آسية الصغرى) فشجعه أسقفها ودافع عنه في رسائل وجهها إلى أصحاب الشأن الديني والعلمي. وفعل الكسندروس الشيء نفسه فكتب سبعين رسالة يوضح فيها آراءه ويبين خطأ آريوس.
انتشرت آراء آريوس في الأجزاء الشرقية من الامبراطورية. وكتب هو الأغاني والأهازيج الروحية التي تحتوي أراءه، فذاعت بين الناس العاديين الذين كانوا يعيدون إنشادها في الأماكن والساحات العامة.
انزعج قسطنطين من ذلك، إذ أن الأمر قسم المسيحيين إلى فرقتين متخاصمتين، وهو لم يحب أن يصل الأمر إلى هذا الحد. وقد قامت محاولات لإصلاح البين، لكن القوم لم يدركوا أن الأمر خلاف عقائدي من الدرجة الأولى. ومعنى هذا أن النصح والإرشاد والتشاور ومحاولة المصالحة لا مجال لها في مثل هذا الأمر. لذلك دعا قسطنطين جميع الأساقفة من جميع أنحاء الامبراطورية للتشاور وإبداء الرأي. وتم الاجتماع في نيقية سنة 325م وكان هذا هو المجمع المسكوني الأول.
ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى معنى الدور الذي اتخذه قسطنطين لنفسه في هذه المناسبة. كان قسطنطين أول توليه الحكم (قبل أن يعتنق المسيحية) يُعتبر "الحبر الأعظم" بالنسبة للأديان التي كانت معروفة ومقبولة رسمياً في الامبراطورية. فلما اعتنق المسيحية واعتبرها ديناً من أديان الامبراطورية اعتبر نفسه حبرها الأعظم. لم يكن رأس الكنيسة، لأن هذه لها رجالها المختصون بشؤونها. بل كان هو يمكنه أن يرأس اجتماعات كبرى لها. ومن هنا فقد ترأس المجمع الذي عقد في نيقية بوصفه الحبر الأعظم لكنه لم ير في نفسه رأساً للكنيسة بل رئيساً "لاجتماع" الأساقفة هذا.
والذي صدر عن اجتماع نيقية هو قانون الإيمان، الذي تمت الوافقة عليه نهائياً في مجمع القسطنطينية (381م)، وهو القانون المعروف باسم القانون النيقاوي.
لكن المجمع، باتخاذه هذا القرار، الذي اعترف بمساواة الابن للآب في الجوهر، لم يقنع الجميع. فلما عاد الأساقفة إلى أبرشياتهم، عادوا إلى الحديث والبحث في قضية "المساواة في الجوهر" .
ظلت القضية حية مدة. لكن الأريوسية ضعف شأنها في المشرق، لأن خلافات أخرى أقوى وأعنف كانت تظهر. فانتقلت هي إلى الغرب وشغلت المؤسسات الدينية هناك. ثم عرفت طريقها إلى الشمال الأفريقي.
كان من أشد خصوم الآريوسية في المشرق أثناسيوس الكبير بطريرك الاسكندرية (327-373م) الذي تولى المنصب ستاً وأربعين سنة. كان شديد الحماسة في دفاعه، عنيفاً في كتاباته، لذلك، وبحكم المدة الطويلة التي قضاها في السدة فقد كان له أصدقاء كما كان له خصوم.
وإذا نحن توقفنا قليلاً لنرى موقف الكنيسة (والمسيحية معها) قبل نيقية وبعدها، وجدنا التطورات التالية:
في الفترة الأولى للمسيحية كانت هناك محاولة للمحافظة على وحدة الكنيسة، وكان الجميع، في غالب الأحيان، يعملون ضد الأباطرة فتغلبوا عليهم. وكانت عضوية الكنيسة أمراً عفوياً فيه حرية وتضحية. كما أن الاعتراف بالإيمان كان قضية شخصية بوجه عام.
أما بعد نيقية فقد فقدت الكنسية تساوقها الداخلي واختلف المسيحيون بحيث أصبحوا يستعدون الأباطرة على بعضهم بعضاً. وكان ثمة مزج بين الكنيسة والدولة، بحيث أصبحت الأولى مؤسسة ذات امتيازات تنالها من الدولة. وصار الحفاظ على الأرثوذكسية، ضد الحركات المخالفة، واجباً على الدولة. وبدا رجال الكنيسة وكأنهم من أهل البلاد. والاعتراف بالإيمان أصبح منوطاً بقانون نيقية ومن يخالفه يعاقب.
وفي مجمع القسطنطينية (381م) رفعت أسقفية العاصمة إلى درجة بطريكية، وجعلت في الدرجة الثانية. فأصبح ترتيب البطريركيات كما يلي: رومة والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية. أما القدس فلم تصبح بطريركية إلا سنة 451م في مجمع خلقدونية وجعلت في المرتبة الخامسة.
عني القرن الرابع أيضاً بكثرة المهتمين بالنواحي اللاهوتية من المسيحية، وفي مقدمتهم غريغريوس النازيانزي (ح330-389م) الذي يعود إليه الفضل في توضيح معنى التثليث المسيحي، لأنه أوضح في وعظه وفي تآليفه معنى الصلة بين الآب والابن والروح القدس من حيث أنهم أقانيم ثلاثة لكنها مترابطة. فالابن مساو للآب في الجوهر والروح القدس مولود من الآب وهو مع الآب والابن.
من كبار آباء الكنيسة في القرن الرابع يوحنا الذهبي الفم (أو فم الذهب) المولود سنة 345م والمتوفى سنة 407م. وقد تولى منصب بطريرك القسطنطينية. لكن أهميته كانت في العظات التي القاها على مستمعيه والتي بلغت المئات. وقد اهتم بتوضيح جميع النواحي المسيحية وواجبات رجال الدين. وكان حريصاً على تثقيف النساك، ذلك أن الرهبنة، التي نشأت على يد أنطونيوس الكبير (290-346م) في مصر، انتشرت فيما بعد في بلاد الشام وقبادوقية وبلاد الرافدين. ويوحنا الذهبي الفم كان حريصاً على أن يفهم هؤلاء النساك، على اختلاف الأخويات التي نشأت في المنطقة، واجباتهم نحو المسيحية والناس.
كان المسيحيون يحتفلون بعيد الغطاس لأنه مرتبط بعمادة المسيح، وبعيد الفصح لأنه ذكرى قيامة المسيح، وعيد العنصرة لأنهم كانوا يحيون فيه نزول الروح القدس. لكن سنة 386م أدخل عيد جديد في لائحة الأعياد المسيحية في الكنيسة الشرقية، وكان هذا قد بدأ الاحتفال به في بطريركية رومة قبلاً. فلما جاء الوقت للاحتفال به في المشرق استغرب المؤمنون هذا الأمر. وعندها تقدم يوحنا الذهبي الفم وألقى وعظتين حول الموضوع، الواحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 386 والثانية يوم العيد بالذات. والعيد هو عيد الميلاد.
وكان بين كبار النساك في منطقة قورش مار مارون المتوفى سنة 420م. وكان له عدد كبير جداً من الأتباع والتلاميذ، منهم إبراهيم الناسك الذي وصل لبنان وأقام في جرود جبيل ونشر المسيحية هناك.
وقد بنى دير مار مارون الرئيسي سنة 452م في أفامية (إلى الشمال الغربي من حماة) إحياءً لذكراه. ومن هنا، كما من المنطقة القورشية وجبل سمعان وحلب وجوارها، انطلق المبشرون وأكثرهم من النساك والرهبان إلى المناطق اللبنانية. وقد كان مار مارون وتلاميذه من المدافعين عن الخلقيدونية.
جاء فلسطين رجال لاهوت من رومه واستقروا فيها. وكان في مقدمتهم القديس جيروم (أيرونيموس) الذي ولد سنة 347م في إيطاليا، وتوفي في سنة 420م في بيت لحم، بعد أن قضى فيها آخر 35 سنة من حياته، وحيث بنى ديراً للرهبان، وبنت رفيقته باولا ديراً للراهبات، كما بنت ميلاني ديراً آخر في جبل الزيتون. كان جيروم من نوابغ عصره. فقد درس اللغة العبرية واليونانية واللاهوت، وكان إماماً في اللغة اللاتينية. وقد نقل الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية، فضلاً عن أنه وضع شروحاً مفصلة وجيدة لأسفار الكتاب نفسه. وترجمة جيروم اللاتينية هي أساس النص اللاتيني الذي تستعمله الكنيسة الكاثوليكية بعد أن أدخلت على النص الأصلي تعديلات وصفت بأنها طفيفة وقد وافق عليها الكرسي الرسولي في القرن السادس عشر.
طبيعة المسيح
في أوائل القرن الخامس اختير نسطوريوس، وهو راهب إنطاكي وعالم وخطيب وواعظ، بطريركياً للقسطنطينية (427م).
وقف نسطوريوس من الفئات الخارجة على الكنيسة، كما كان هو يفهم المسيحية، موقفاً عنيفاً إذ اعتزم القيام بحملة تطهير واسعة. فضلاً عن ذلك فقد كانت له آراء خاصة بألوهية المسيح وإنسانيته. وعمل على توضيح وجهة نظره بكل ما أوتي من علم ومعرفة ومقدرة على الخطابة والإقناع. وكان من مؤيدي نسطوريوس يوحنا بطريرك إنطاكية الأساقفة الشرقيون أي الذين يتبعون هذا الكرسي ومجاوريهم.
وكان كيرللس بطريرك الإسكندرية (412-444م) خصم نسطوريوس في آرائه. والخلاف بين الرجلين كبير. وكان كيرللس عالماً لاهوتياً كبيراً وزعيماً لا للكنيسة القبطية فحسب، بل يكاد يكون زعيم البلد، إذ أنه هو الذي كان يسيّر أو يقود الحركة الوطنية المصرية يومها. وكان كيرللس يرى أن المسيح له الصفة الإلهية الكاملة، وهي التي اتحدت معها الطبيعة البشرية.
يرى البعض من الباحثين بأن الخلافات كان من الممكن أن تحل بالمناقشة الهادئة واعتماد الألفاظ الدقيقة، أو بعد جعلها دقيقة لتتفق مع المعاني الجديدة التي حملتها. لكن القضية لم تكن قضية خلافات لاهوتية فحسب، بل كانت هناك أطماع ومنافع فضلاً عن خلافات مجتمعية.
أراد ثيودوسيوس الثاني (408-450م) أن يضع حداً لهذه الخلافات والمهاترات والدسائس التي رآها تعصف بالكنيسة، فدعا، على عادة أسلافه وخلفائه، إلى مجمع يعقد في أسقف أفسوس (431م). جاء كاريللس ومؤيدوه، واستطاع أن يستميل ممنون أسقف أفسس إلى جانبه، وتأخر أنصار نسطوريوس وهم يوحنا بطريرك إنطاكية وأساقفته (أو لعلهم أعيقوا في الطريق عمداً) عن الوصول في الوقت. وتعمد كيرللس أن يفيد من ذلك فأصدر مع ممنون قراراً بقطع أو حرمان نسطوريوس. فلما وصل يوحنا الانطاكي قطع أي حرم كيرللس وممنون. وقد وافق الامبراطور ثيودوسيوس على القرارين وطرد الثلاثة من مناصبهم.
قبل نسطوريوس أمر الامبراطور وخرج من العاصمة عائداً إلى ديره، ثم نفي إلى البتراء وأخيراً نفي إلى ليبيا حيث قضى بقية عمره في واحة نائية (تو. 452م).
تبع هذا المجمع، الذي ظلت قراراته (عدا ما خص نسطوريوس) معلقة في الهواء، هدنة. فقد عاد كيرللس إلى الاسكندرية وصرّف شؤون بطريركيته وجماعته وظل ممنون في أفسوس. ويبدو أن الجميع قد تعبوا بعض الشيء فكان هناك هدنة عقائدية استمرت بضع عشرة سنة. لكنها تحركت ثانية.
كان اوطيخة راهباً زاهداً ورعاً محترماً. وكان البلاط يجله. وقد رأى أوطيخة رأي كيرللس، ولعله تقدم حتى على كيرللس فقال أن الطبيعة الإنسانية في المسيح امتزجت بالطبيعة الإلهية حتى تلاشت فيها "تلاشي نقطة خمر وقعت في ماء". فالمسيح كان، في رأيه الواضح، اقنوماً واحداً وطبيعة واحدة. ونشر أوطيخة آراءه في العاصمة. ووقف لأوطيخة في المرصاد دمنوس الذي كان يقول بغير ذلك. وبعث إلى الامبراطور بشكوى ضد أوطيخة.
وكان الامبراطور قد أصدر (448م) إرادة حرم فيها تعاليم نسطوريوس وجميع المصنفات التي تخالف نصوص نيقية وافسوس وقراراتهما. وهنا بدأت الدسائس ونشرت الأكاذيب حول مختلف رجال الكنيسة. وكان ديوسقوروس قد خلف كيرللس بطريركاً على الاسكندرية (444-451م). وهو لم يكن أقل مقدرة على الدس ونشر الإشاعات من غيره، فضلاً عن أنه كان أعنف من سلفه كيرللس.
ارتأى الامبراطور أن يدعو إلى مجمع ثان في أفسوس (آب-أغسطس 449م). واختار الامبراطور بعض الأشخاص لحضور المجمع ومنع آخرين من الحضور. وقد اجتمع هذا المجتع "الهزؤ" بمئة وثلاثين من الأساقفة (بل لعل العدد تجاوز هذا الرقم). "وكانت القرارات تصدر عشوائياً كما يبدو، لكن كل شيء كان قد دبره ديسقوريوس ومحازبوه". واغتنم هذا بلبلة أحدثها هو وصحبه فاستعان بممثلي الامبراطور، "ففتح هؤلاء أبواب الكنيسة وأدخلوا إليها الجند والرهبان والبحارة المصريين وغيرهم من عناصر الغوغاء. وعبثاً حاول فلابيانوس (أسقف القسطنطينية) الالتجاء إلى قدسية المذبح فإن الرهبان جروه جراً فوقع على الأرض فداسه ديوسقوروس وجماعة برصوم وأخرج خارجاً وسجن وتوفي بعد ثلاثة أيام وهو في طريقه إلى المنفى. واتهم ديوسقوروس بقتله فعلاً".
سمي هذا المجمع بـ "المجمع اللصوصي" بسبب ما جرى فيه من أضاليل وأكاذيب وما مررت به من قرارات مبنية عليها.
وقف ثيودوسيوس من كل هذا موقف الموافق لأنه رفض طلب الكثيرين ومنهم الأسقف الروماني في وجوب عقد مجمع مسكوني لإعادة النظر وتصحيح الأوضاع. لكنه كان يقول أن ما جرى كان كافياً وأنه لا حاجة إلى عقد مجمع آخر.
فلما تولى العرش مرقبان (450-457م) دعا إلى مجمع مسكوني رابع، عقد في خليقونية سنة 451م. ولبى دعوة الامبراطور خمسمئة أسقف (وقيل أن العدد كان أكبر من ذلك إذا حسبنا بعض الشيوخ والشمامسة الذين انضموا إليه)، وانعقد المجمع في خلقيدونية. وكان مندوبو البابا ليون الكبير (441-461م) في طريقهم إلى المجمع حاملين معهم "الرسالة" (المعروفة باسم طومس) التي حررها البابا.
هذه الرسالة تلخص التفكير اللاهوتي الغربي (الذي كان يتفق مع تفكير القسطنطينية وإنطاكية أصلاً) وقد صيغ باللغة اللاتينية. وخلاصة ما فيها أن المسيح شخص (أو أقنوم) واحد له طبيعتان. ويبدو أن اللغة اللاتينية كانت أوضح وأصفى من اللغة اليونانية التي بلبلتها الفلسفة كثيراً، وزاد في بلبلتها، بالنسبة للاهوت، النقلة التي أضرت بها بسبب التطور الفكري العقائدي المسيحي.
على كل، كانت الرسالة واضحة وهي تتفق مع وجهة نظر القائلين بالطبيعتين في المسيح. وقد يكون هناك خلاف في أسلوب التعبير.
كان القصد الأصلي من مجمع خلقيدونية تصحيح الأخطاء التي آل إليها مجمع اللصوص (449م) كما سمي. فتقرر خلع ديرسقوروس من منصبه، وطلب من رجال الدين الانطاكيين أن يدينوا نسطوريوس.
على أن مندوبي الامبراطور ألحوا على المجمع بوجوب وضع وثيقة عقائدية واحدة، سواء قبل المجمع فكرة الطبيعة الواحدة أو رأي الطبيعتين بالنسبة للمسيح. واستجابة لهذا الالحاح وضع المجمع، على يد لجنة مثلت جميع الآراء، مشروع اعتراف موحّد.
فالذي حدث بعد ذلك هو ما عرف بالانشقاق الخلقيدوني. يمكن تلخيصه بثورة قام بها الرهبان الآراميون-السريان (السوريون) المترهبون في فلسطين. وقد رافقها شغب كبير احتاج إلى الاستعانة بالجند لوضع حد له. وقامت في الاسكندرية حركات دينية وطنية وأخذت كنيستها بقاعدة الطبيعة الواحدة. ولم تكن الاسكندرية أو بيت المقدس (وجنوب فلسطين) الوحيدتين في ذلك.
وقد تأنى الأباطرة البيزنطيون في فرض رأيهم هذه المرة، إذ تركوا الأمور تستقر بشكل من الأشكال. ومع ذلك فإن زينون (476-491م) نشر وثيقة سماها أونوطيقون، وذلك سنة 482م، وهي التي يمكن أن تسمى "وثيقة الوحدة". كانت الوثيقة معتدلة وصحيحة ولم تشر إلى التطرف قط. ويبدو أنها قبلت لأن المسؤولين من رجال الدين، أو البعض على الأقل، تعبوا من الجدل والمناقشة والخلافات.
وقد وضع حداً لهذه الفترة من السلام تدخل بابا رومة فيلكس الثالث (483-492م)، الذي قطع (أي حرم) أكاسيوس بطريرك القسطنطينية، لأنه تجنب استعمال الحدود الخلقيدونية. فشجع هذا جميع خصوم الوثيقة ومؤيديها على التخلي عنها. وهذا الذي كان يحدث دوماً. فإذا تقدم المعتدلون في القسطنطينية بقبول آراء الطبيعة الواحدة تصدت روما لهم وحرمتهم، فإذا تصالحوا مع الغرب قامت قيامة الاسكندرية ومن ورائها مصر بكاملها.
على أن الأمر لم ينته بالمسيحية عند هذه النقطة أو القضية. فلا المشكلة حلت ولا الخلافات توقفت. فبعد نحو قرنين قامت حرب الإيقونات. ثم نما وتزايد الخلاف بين دور الرئيس الديني في تفسير العهد الجديد؛ إذ أن الكنيسة الغربية الكاثوليكية انتهى بها الأمر إلى أن أصبح البابا هو المصدر الوحيد لتفسير القضايا المسيحية، والعقائدية خاصة.
ولما قام رجال الإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر ورأوا أن يعاد النظر في الشؤون المسيحية، لم يقتصر الأمر على الخلاف حول الشكليات والإدارة، بل تناول جميع القضايا وأهمها حق تفسير الكتاب المقدس وأصول القواعد اللاهوتية.
لا يزال رجال الدين المسيحيون، على اختلاف مللهم ونحلهم، يختلفون على أمور كثيرة. وهذا أمر قد لا يكون كله شراً على المسيحية. فالتحاك الفكري أمر فكري مهم في الحياة الفكرية والروحية والاجتماعية لكل جماعة.